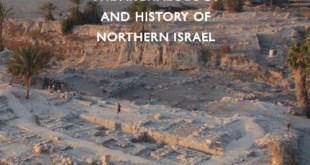نقرأ بين الحين والآخر في الصحف الإسرائيلية مقالات تعرب عن أسفها من موقف “المؤرخين الفلسطينيين” الذين يكتبون إسرائيل انطلاقاً من التاريخ القديم لفلسطين. وظهرت قبل سنوات قليلة دراسة مهمة لكل من موتي غولاني وعادل مناع تناقش الطريقة التي يتم بموجبها إزالة ” الآخر” من التاريخ الحديث عندما يتعلق الأمر بحرب العام 1948 .فما هو تاريخٌ لجماعة، ليس تاريخاً لجماعة أخرى ( Two Sides of the Coin: Independence and Nakba 1948. Two Narratives of the 1948 War and its Outcome [English-Hebrew edition].2011). فلماذا فلسطين؟ ولماذا إسرائيل؟ ولماذا اليهود؟.. ولماذا اختارت الصهيونية استحضار التراث الثقافي والديني اليهودي واستثمار هذا التراث لحل ما يعرف بـ”المسألة اليهودية” ؟ لماذا كل هذا الهوس الذي بدى كأنه سعار يستحوذ على عقول الكثير لإعادة كتابة التاريخ الفلسطيني؟
وإذا اتفقنا على تعريف الحركة الصهيونية بصفتها حركة استعمارية أوروبية متمركزة إثنياً ذات نزعات ليبرالية قومية، أو بالأحرى يراد لها أن تكون ذات طابع قومي؛ تقوم على مبدأي تحرير “الوطن التاريخي” وتوحيد “الشعب المختار التاريخي” وصولاً للانعتاق الفردي “كمبدأ ليبرالي” وتحقيق السيادة الإثنية “كمبدأ قومي” المتداخلين مع تصورات جغرافية وإقليمية عن الوطن المتخيل للسيطرة على “الفضاء المكاني” أو على الأقل تهويده بأثر رجعي وبطريقة مغايرة لمسار التاريخ.. إذا كان المشروع كل ما سبق،، فلماذا ما زال يعاني من مآزق وجودية رغم إنجازه السياسي بقيام الدولة منذ أكثر من سبعين عاما؟
يقع مفهوم الأرض في قلب هوية الصهيونية السياسية -الدينية، إذ لا يكتمل مفهوم السيادة على “أرض إسرائيل” دون معطياتها اللاهوتية، ويستلهم بن غوريون-في طريقه نحو بناء “الأمة”- الأعمال الأسطورية لبطاركة نصوص العهد القديم؛ فيقول: “إني أعتبر يشوع بطل التوراة بلا منازع، لأنه لم يكن مجرد قائد عسكري بل كان المرشد لتوصله، عن طريق المجازر، إلى توحيد قبائل بني إسرءيل”. وهذا ما يفسر العلاقة بين السيادة اليهودية الدينية والطموحات الاستعمارية للصهاينة الأوروبيين، فيشبه بن غوريون المعارك العنيفة، والمذابح الجماعية التي نفّذها الصهاينة ضد الفلسطينيين بتلك التي “شنّها المستوطنون البيض ضد الطبيعة المتوحشة وضد الهنود الأكثر وحشية”، ويتماشى هذا الوصف مع تصور هرتزل للصهيونية باعتبارها “فكرة استعمارية”.
وفي موقع ليس بعيد عن هذه الأجواء يقع كتاب شلومو ساند (اختراع الشعب اليهودي) الذي ظهر في العام 2008 بنصه الأصلي، ثم ظهرت الترجمة الفرنسية والإنكليزية للكتاب على التوالي (نال جائزة فرنسية لأحسن كتاب للعام 2008). وتأخرت الترجمة العريية حتى العام 2011، عندما قام المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية( مدار) بترجمة الكتاب مع مقدمة للمؤلف الإسرائيلي من أصول بولونية.
في البداية لابد من تسجيل ملاحظة مهمة وهي أن الكتاب ما انفك، منذ ظهوره، يثير حالة جدل واسعة سواء لمؤيديه أم لمعارضيه. فقد هبط كالصاعقة على بنية الذاكرة الثقافية لسردية الوجود “اليهودي الديني القومي” في فلسطين، وهو إذ يحاول خلخلة هذه البنى المؤطرة بالأساطير الدينية فقد هبت في وجهه عاصفة لم تهدأ من الاعتراضات والانتقادات. ومن الواضح أن اليهود الإسرائيليين والصهاينة والمسيحيين الأصوليين في فلسطين وخارجها لن يتخلوا بسهولة عن “ذاكرتهم” الثقافية كرمى لعيون باحث حصيف حتى لو كان من آل بيتهم، وهو ما يفسّر ردة الفعل العنيفة ضد الكتاب حيث يعتبر للعديد من القراء الإسرائيليين (وغير القراء) ربما أسوء كتاب تم نشره منذ قيام الدولة؛ لاسيما فيما يتعلق بمقولة “الشعب اليهودي”، وقد علّق ساند نفسه على ذلك قائلاً: “بعد سنوات وسنوات من استخدام تعابير مثل (الشعب اليهودي) و(القومية اليهودية) لأكثر من أربعة آلاف سنة، ليس من السهل تقبل كتاب مثل كتابي”. بيد أن ليس الأمر هكذا فقط، فالهجمة على المؤلف ليست لأن الكتاب سيء أو لأن المؤلف لم يكن مصيباً فيما ذهب إليه هنا أو هناك؛ بل أيضاً لأن ساند (وهذه نقطة تسجل له) تحدى -بطريقة ما- هيبة سلطة الذاكرة الإسرائيلية المعاصرة حين وقف في وجه سردية الذاكرة الثقافية الرسمية للدولة التي تأسست على مزيج من الفكر “القومي” المتعصب والمتمركز إثنياً ونصوص العهد القديم وإرث اللاهوت الديني اليهودي الذي يحظى بدعم من المجتمع اليهودي والمسيحي المؤمن على حد سواء.
وهنا يحقُّ لنا رمي بذرة سؤال نأمل لها أن تنبت إجابات بينة :هل ينبغي -من الناحية النظرية على الأقل- لمثقف (مثل شلومو ساند أو غيره) أن يكون ممثل لهذا المجتمع القديم؟ أي إسرءيل القديمة التي وجدت -زعماً- في زمن مضى في فلسطين؟ آخذون بعين الاعتبار أن مثل هذا الزعم ما زال غير مؤكد؛ فثمة جدل كبير يدور في الأوساط المختصة يخالطه شك يكاد يتحول إلى يقين حول ما إذا كانت إسرءيل القديمة ليست سوى اختراع غريب لا يمت بصلة لتاريخ فلسطين والشرق القديم عموماً.
تستند المقولة الرئيسية للكتاب إلى نفي المزاعم التي تعين “قومية يهودية” نقية لـ “شعب يهودي”؛ شعب عتيق واحد وموحد عبر الزمن، شعب يمثل ثابتاً عنيداً في حركية التاريخ. شعب يعود لأصول إثنية وبيولوجية واحدة ذات جذر منفرد ومتفرد، حسب التصورات الصهيونية، على أن لا يفهم هذا النفي بوصفه لمعتقداتهم ورؤيتهم للعالم أو (تاريخهم) أو إنكاراً لليهود” [إنكار اليهود بوصفهم ماذا؟!.. هنا يكمن المأزق الذي وضع ساند نفسه فيه] .وهو يرى في اليهودية ديناً مثله مثل المسيحية والإسلام عابراً للقوميات ليس محصوراً أو مقصوراً على قومية أو “إثنية “محددة فأتباعه ينتسبون إلى قوميات وإثنيات وجغرافيا متنوعة ومختلفة وممتدة يرتبطون برابط الدين ليس إلا .”فلو أن اليهود كانوا حقاً (شعب)، فما هو الشيء المشترك في مكونات الثقافة الإثنوغرافية ليهودي في كييف ويهودي في المغرب غير الاعتقاد الديني وبعض الممارسات الدينية؟”( ص 43). وعند هذه اللحظة يحاول الكتاب تفسير كيف تم “اختراع الشعب اليهودي، وكيف فبركت الحركة الصهيونية تاريخاً مزيفاً لليهود مبنياً على فكرة الشعب اليهودي” ثم يحاول أيضاً، بجهد ورصانة، تفكيك هذه المقولات وإظهار خطئها وطابعها الخرافي؛ وكيف استعملت لتسويغ احتلال إسرائيل لفلسطين وشن الحروب ضد الدول العربية الأخرى المجاورة، ويتابع ساند، في هذا السياق/ التأكيد على التعريف الرائج حالياً لمفهوم “الشعب” لا ينطبق على اليهود بأي حال، فالشعب في معناه الأنثروبولوجي والسوسيولوجي يقصد يه أي جماعة بشرية يجمعها ثقافة مشتركة (لغة، أدب، موسيقا.. إلخ، وانحدار أفراده من أصل سلالي مشترك [ لا يشترط في تعريف الشعب هنا وحدة الإقليم الجغرافي في إطار دولة معترف بها أممياً ]) هذا ما لا ينطبق على “الشعب” اليهودي الذي اخترعته حركة إثنية سياسية استعمارية في القرن التاسع عشر وبزوغ عصر القوميات، وبتأثير من أفكار القومية الألمانية قام المشروع الصهيوني بـ “صهينة” اليهودية لصالح مشروع “قومي” سيقوم لاحقاً بإنشاء دولته في فلسطين دامجاً الدين و الإثنية والقومية في تركيب معقد يستمد مسوغاته القومية وبأثر رجعي من الدين والماضي والتاريخ. وعلى هذا فإسرائيل الحديثة “هي مشروع سياسي تم تخيله في أواخر القرن التاسع عشر، فأصبحت واقعاً من خلال الهولوكوست، ثم تأسست في العام 1948”.
مرحى يا شلومو ..مرحى .. ها أنت هنا تحاول كتابة تاريخ.. وأي تاريخ !!.
إذا كان ” التاريخ في المقام الأول هو تاريخ زمن كتابته” كما يستشهد ساند بعبارة الفيلسوف الإيطالي بنديتو كروتشة ( ص 310) ،فالتاريخ الفلسطيني؛ أو تاريخ فلسطين ما زال يراوح بالنسبة له بين عطالة تاريخية مقصودة وزهو قومي استشراقي مثير للضجر و الشفقة بآن حين يروج لنا (وأقصد لقرائه العرب” أنه ” ينبغي الاعتراف بإسرائيل لا كدولة “الشعب اليهودي” بل كدولة كل المواطنين الإسرائيليين المقيمين فيها بغض النظر عن أصلهم أو ديانتهم… ورغم أن إسرائيل ولدت من خلال خلق كارثة فظيعة للسكان المحليين [ لم يكلف خاطره أن يقول عنهم فلسطينيين] فقد تشكل في المنطقة واقعاً لا يؤدي إنكاره الكلي إلا إنتاج مزيد من الكوارث الجديدة ” (ص 10 – مقدمة ساند للطبعة العربية). وهو ذات الأمر الذي يصفق له إريك هوبسباوم حين اعتبر كتاب ما يكتبه ساند “تمرين ضروري في حالة إسرائيل من أجل تفكيك الخرافة القومية التاريخية والدعوة إلى إسرائيل التي يتشارك فيها على قدم المساواة سكانها كافة” (مازلت لم أهضم منطق هوبسباوم الغرائبي هذا صاحب عصر الثورة الذي جعله يقول مثل هذا الهراء التلفيقي بنزعته الترقيعية ).
ولكن! ماذا يعني كل هذا؟ أو لنقل السؤال بطريقة أخرى؛ ماذا يعني للفلسطيني كل هذا بأي حال؟
يحاول ساند أن يكتب “إسرائيل” من تاريخ فلسطين. فكل ما يمكن أن نطلق عليه تاريخاً -على حد قول الباحث الدنماركي المتخصص في تاريخ فلسطين القديم نيلز بيتر لامكه- في الحقيقة ليس سوى تاريخ تم اختراعه بطريقة ما، أو هو، بأحسن الأحوال، ذاكرة ثقافية ذات سمة مجتمعية، وعندما يتواجد أكثر من جماعة بخلاف الجماعة الموجودة في الحاضر ضمن مجتمع معطى، فيمكننا أن نخمن وجود أكثر من ذاكرة ثقافية، ولو توسعنا في القول وافترضنا وجود صراع بين الجماعات؛ فمن المنطقي الاستنتاج أن المنتصر هو من سيقرر أي ذاكرة من هذه الذواكر هي “الصحيحة” والتي يجب تدوينها وتلقينها لطلبة المدارس. ربما هذا الأمر يدفع بالمؤرخ للاعتراض نظراً لأنه أقدر من غيره على معرفة “النسخة الصحيحة” ، ولكن للأسف يبدو أن المؤرخين، في الواقع، لا يميلون كثيراً للاهتمام “بالحقائق” التاريخية، ربما لعدم استطاعتهم السيطرة على الذكريات. أو لخوفهم منها كخوف الغزاة، أو لأنهم يمثلون من ناحية أخرى السلطة السياسية وخياراتها بغض النظر عما قد يتفق عليه الشعب على أنه “تاريخ”.
من الواضح أن محو التاريخ الفلسطيني بعد العام 1948 كان عملاً سياسياً متعمداً. ولذلك لا ينبغي أن يكون مفاجأة “وهنا تبدو الإجابة على شكوى وتذمر هآرتس” منطقية عندما يعيد الفلسطينيون دحرجة التاريخ أيضا نحو ماضٍ معين لا تكون فيه إسرائيل من سكانه ولا حتى ضيفة شرف فيه. وهذا ما يفسر طراز “القومية” الذي تزعمه الحركة الصهيونية الذي يقوم بالدرجة الأولى على توهم أسطوري مغرق في الرجعية والعنصرية وبعيد كل البعد عن أي معنى “تاريخي” حقيقي وتختلط فيه المشاعر الدينية بالتطلعات القومية لتخلق مزيجاً هجيناً يتشبث بمزاعم العودة لوطن قديم وأرض موعودة تأسيساً على نصوص دينية: “18 فِي ذلِكَ الْيَوْمِ قَطَعَ الرَّبُّ مَعَ أَبْرَامَ مِيثَاقًا قَائِلًا: «لِنَسْلِكَ أُعْطِي هذِهِ الأَرْضَ، مِنْ نَهْرِ مِصْرَ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ.19 الْقِينِيِّينَ وَالْقَنِزِّيِّينَ وَالْقَدْمُونِيِّينَ20 وَالْحِثِّيِّينَ وَالْفَرِزِّيِّينَ وَالرَّفَائِيِّينَ21 وَالأَمُورِيِّينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ وَالْجِرْجَاشِيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ». (تكوين 15: 18-20)، فالمشروع الصهيوني كما يراه “ساند وزملاءه من المؤرخين الجدد” يحمل الكثير من المخاوف في أن يكون مدمرا لمن ينتسبون لليهودية، ولعل هذا ما وضحه بيني موريس، أحد أهم رموز هم : “إن المشروع الصهيوني كله مشروع أخروي، إنه يقوم في محيط معاد، وبمعنى ما فإن وجوده لم يكن منطقياً أن ينجح في العام 1948، وليس من المنطقي أن ينجح الآن، ومع ذلك وصل إلى ما وصل إليه، وبمعنى آخر فإن في الأمر معجزة.. قد يكون الخراب نهاية هذه العملية وهذا ما يخيفني”.
بعد قيام دولة إسرائيل عمد الفكر الاجتماعي الصهيوني إلى تبني ترتيبات ما بعد الخطوة الصهيونية القومية وفقاً لتغيرات النسق السياسي وعملياته الجارية لبناء دولة قومية بأغلبية يهودية قوامها الأساسي مجتمع المستعمرين اليهود في فلسطين الانتدابية؛ وتالياً مجتمع المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 والتي يحلو لغلاة اليمين الإسرائيلي تسميتها “قلب أرض إسرءيل” كإشارة إلى المرويات الدينية “الخلاصية”، فتخليص الأرض و “تحريرها” من الأغراب هو شرط مسبق لتحرير الشعب اليهودي.
يقوم شلومو ساند بتفكيك خطاب الهوية من خلال تعريفه للصهيونية كحركة قومية وإثنية مركزية متشددة استطاعت إنجاز مشروعها التاريخي باحتلال الأرض وطرد الشعب الفلسطيني منها، وأسرلة يهود العالم بما يعزز تشكيل هوية متجانسة مستقبلاً عبر عملية “أثننة متزايدة في سياسة الهويات برزت إبان السبعينات-في أعقاب السيطرة على جمهور واسع أخذت تشكل تهديداً متأججاً في المتخيل القومي الإسرائيلي “(ص 303). ويقول ربما بلغة “التهديد والوعيد ربما” إن إنكار هذا الوجود الصهيوني في فلسطيني يعني هدم المعبد من الداخل . وعليه فإن أفضل ما يمكن أن تفعله إسرائيل -يقول ساند- هو الاعتراف بأن أمتها هي أمة مخترعة، ويجب عليها، كما يجادل، أن تصلح نفسها لأن الدولة تنتمي إلى كل مواطنيها، سواء كانوا يهوداً أم عرباً، وهذا ما يؤكده في المقدمة التي كتبها للنسخة العربية من الكتاب من خلال التوضيح لقرائه العرب أنه مع حق الشعب الفلسطيني وإن هذا الشعب قد ظلم، غير أن هذا لا يعني أنه سيترك البيت الذي يسكنه الآن حتى لو كان أقيم على أنقاض قرية أو مدينة فلسطينية ويستمر في نفس الادعاء على مدار الأربعمئة صفحة التي يتكون منها كتابه.
وأكاد أزعم -كفلسطيني- أن ليس مهماً، ولا يعد انتصاراً إقرار كاتب تاريخ أو عالم آثار إسرائيلي بعدم جدوى البحث عن تاريخ وماضي وقصص آباء وأنبياء وملوك العهد القديم في فلسطين، فمثل هذا السجال هو محض نقاش أكاديمي ينحصر في دائرة ضيقة من القراء لا يتعداها إلا نادراً، بيد أنه يأتي في سياقات منهجية تسعى للبحث عن مخرج للأزمة البنيوية للمشروع الصهيوني بما يوحي أنه ما زال مكبلاً بأقمطته الصهيونية؛ وإن كان يتبنى تسميات مختلفة على غرار “المؤرخين الجدد” أو الفكر ما بعد الصهيوني “.
ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الكتاب أتى بعد انتفاضتين شعبيتين في فلسطين وضمن أجواء سيطرت على الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت شرارتها في العام 1987 والتي عرفت باسم “انتفاضة أطفال الحجارة” فبدأ الكتاب الإسرائيليون القيام ببناء نقد “حداثي” للحركة الصهيونية ولفكرها وجوهر مشروعها في المنطقة من خلال تفكيك الأزمات التي تعاني منها إسرائيل جاهدين في استيلاد صيغ تجديد هذا الفكر وإعادة تركيبه بما يضمن تأبيده. ويقر جزء منهم بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة هو “احتلال”؟ وعندما ينظر هؤلاء لبعض المفاهيم مثل” العالم” فإنه يفهم من سياق كلامهم أنه يعني بالإضافة إلى إسرائيل أوروبا وأمريكا ويكون محيط إسرائيل مجرد كيانات ومجتمعات شرق أوسطية، بتعبير مبهم تغلب عليه الجغرافيا السياسية أكثر من المقولات التاريخية-الاجتماعية، وبالتالي لا ترقى تلك الكيانات إلى مستوى انضمامها للنادي “العالمي”. وتكتسب هذه الكيانات أهميتها فقط عندما يدور الحديث عن قضايا الأمن والاقتصاد والسوق و”الديمقراطية”، وهذا ما يظهر في الخطاب الصهيوني منذ التأسيس والذي تبرز مفاعيله باستخدام أدوات استشراقية لتعريف الآخر وتعيينه. وهكذا سيطر على هذه الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، فضلاً عن العديد من المهتمين بشؤون الشرق الأوسط هوساَ بدى كأنه سعار يستحوذ على عقولهم لإعادة كتابة التاريخ الفلسطيني.
وفي الحقيقة، ومن خلال قراءتي المتواضعة لما جاء في الكتاب، لم أعثر على نقد أو رفض لمقولة “حق اليهود” في فلسطين على أساس ديني. ولابأس من القول إنه مع حق الشعب الفلسطيني (لست أدري ما طبيعة هذا الحق الذي يقصده وأين تقف حدوده). غير أن ما ينبغي النظر فيه حقاً الحفر العميق الذي اشتغل عليه ساند لجهة توضيح العديد من الركائز التي تعتبر أساسية اليوم في اليهودية مثل “الشتات” و “الوعد” و”أرض إسرءيل” وهي مفاهيم، مثل مفهوم “الشتات” على سبيل المثال؛ يرى أنه ظهر مع الفترة المبكرة للمسيحية، وكان الهدف منها-مسيحياً- جذب اليهود للديانة الجديدة. وكان أكثر جرأة حين اعتبر فكرة “عودة اليهود إلى أرض الميعاد” غريبة وبعيدة كل البعد عن العقائد اليهودية، وهي لم تتكرس أصلاً إلا مع ظهور الحركة الصهيونية و”اختراع” “القومية اليهودية” على يد عدد من المثقفين اليهود الألمان، فالنظرة السابقة لفلسطين بالنسبة لليهود اعتبارها ” أرض مقدسة ” ليس من الواجب أو الضرورة السكن فيها [تماماً مثلما ينظر المسلمون إلى مكة و المدينة المنورة].
يشير ساند إلى أسطورة “المنفى” في الوعي الجمعي اليهودي والتي تعود بداياتها إلى “خراب الهيكل الثاني” في العام 70 ميلادية على يد الرومان؛ والتي كانت إحدى الركائز الأساسية التي “خلقت” خرافة “الشعب اليهودي الواحد والموحد” ولعل قوة الدراما في هذه السردية تكمن من حجم المأساة التي لحقت بالمجتمع اليهودي غي “أورشليم” آنذاك؛ وهذا ليس مستغرباً إذ لطالما كانت مآسي التشرد والنزوح تشكل مفاصل هامة في تاريخ الجماعات الإنسانية ( نحن المسلمون مازلنا نؤرخ تقويمنا السنوي بهجرة الرسول لما كان لهذا الحدث من أهمية مفصلية في تاريخنا كجماعة إسلامية)؛ ولهذا استعرنا مجاز “الاقتلاع” بما يشبه قلع النبتة من جذورها ومن تربتها الطبيعية ونقلها إلى مكان آخر غريب. لعبت ثيمة المنفى ورديفها الشتات دوراً مهماً في تشكيل وعي قومي وذاكرة جمعية في إسرائيل المعاصرة.
غير أن السردية شيء وحقائق التاريخ شيء آخر، فرغم البعد التراجيدي لسرديتي النفي والشتات في العصر الروماني، يؤكد الكتاب صعوبة العثور على إشارات، ولو بسيطة، في وثائق تلك الفترة عن حصول نزوح بهذه الحجم من فلسطين، وأورشليم تحديداً، فمثل هذه السردية تتعارض أصلاً مع الأسس الاقتصادية المحضة؛ نظراً لحاجة الرومان -والآشوريين من قبلهم- إلى بقاء العمالة الزراعية ودافعي الضرائب من السكان المحليين لتمويل نفقة جيوشهم -وهذه قاعدة اقتصادية عسكرية معروفة أثبتت صحتها على مدى وجود الاجتماع الإنساني عبر التاريخ، ومثل هذا الخروج الجماعي يشير إلى نذر كارثة محققة للمحتل؛ وسوف يتسبب بخسائر فادحة له إذا ما اعتبرنا أن وجوده ليس احتلالاً استيطاني إحلالي. فضلاً عن أنه لم يعرف عن الرومان، تاريخياً، استخدامهم سياسة نقل شعوب وجماعات سكانية برمتها من أماكن توطنها إلى أماكن أخرى. بالإضافة إلى التأكيد التاريخي على أن اليهود في تلك الفترة لم يقتصر وجودهم على فلسطين، بل تواجدوا في مصر وفارس والعراق وآسيا الصغرى وغيرها من الأقاليم. كل هذا يدفع ساند للاستنتاج بأن لا وجود لمنفى يهودي يعود للقرن الأول الميلادي على يد الرومان، ولا يوجد مثل هذا “الحدث التاريخي” إلا في عقول الصهاينة لخلق مجاز “أرض إسرائيل” كأداة تمكنهم من المطالبة بفلسطين وطناً لهم، وقد يمتد هذا الوطن ، بسبب النهم الاستعماري، ليصل إلى حدود نهر الفرات شرقاُ والنيل غرباً.
كانت خرافة “المنفى” ضرورية للقوميين الصهاينة لبناء خرافة أخرى هي “أرض إسرائيل” باعتبارها الوطن “القومي الطبيعي” لـ “الشعب اليهودي” مثله مثل أي وطن قومي لأي شعب آخر يتمتع بتخوم طبيعية وحدود جمركية وسياسية يكون سكانه على استعداد للتضحية في سبيله، كما يوجز بنديكت أندرسون في “الجماعات المتخيلة”، وسوف تساهم عوامل كثيرة في تعويم مصطلح “أرض إسرائيل” الذي هو بالأساس مصطلح ديني لاهوتي حوّلته الأدبيات الصهيونية إلى تعبير جيوسياسي، وهذا ما يدفع ساند للاستنتاج بأن “أرض إسرائيل” لا تعني “أرض اليهود” أو “وطن اليهود” ..
باختصار لا يمكن القول إن “أرض إسرائيل” الكتابية هي وطن اليهود؛ وإنما تحولت إلى ذلك مع نهاية القرن التاسع مع الحركة الصهيونية في سياق المد الاستعماري الأوروبي المباشر للعالم غير الأوروبي. وتكرست في الكتابات الصهيونية المبكرة [موسى هس(1812-1857) وكتابه “روما والقدس” (1862) على سبيل المثال]. حين اعتبر أن معضلة اليهود الوجودية تكمن في عدم امتلاكهم وطن قومي يخصهم وحدهم أسوة بشعوب الأرض كافة. وهذا ما سوف يؤكده دافيد بن غوريون لاحقاً في “وثيقة الاستقلال” (14 أيار 1948): ” نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وفيها اكتملت هويته الروحانية والدينية والسياسية، وفيها عاش لأول مرة في دولة ذات سيادة، وفيها أنتج قيمه الثقافية والقومية والإنسانية؛ وأورث العالم أجمع كتاب الكتب الخالد. وعندما أجلي الشعب اليهودي عن بلاده بالقوة؛ حافظ على عهده لها وهو في بلاد مهاجره بأسره ولم ينقطع عن الصلاة والتعلق بأمل العودة إلى بلاده واستئناف حريته السياسية فيها“.
ولعل شدة وتطرف التصورات “القومية” الصهيونية شكلت حاجزاً معرفياً يصعب اختراقه، إذ بات الآن تعبير “الشعب اليهودي” مقولة مقبولة حتى في الوسط الأكاديمي، يصفها ساند بـ “طبقات لذاكرة جماعية، عليه أن يستهلكها قبل أن يُصبح باحثًا مهنياً… تخلق عالماً مُتخيّلاً… تغرس في ذاكرته “حقائق” لا يمكن التفكير إلّا من خلالها” ( ص- 10)؛ وهكذا صار اليهودي يرى نفسه جزء من شعب ينحدر من جذور شعب يهودي عريق وليس فرداً في جماعة دينية، فبات اليهودي عضواً في جماعة “قومية” أو “شعب يهودي منذ نزلت التوراة في سيناء، ويتحد كل اليهود من نسله، وإنه خرج من مصر واحتل “أرض إسرائيل” التي وُعِد بها. وقامت مملكة داوود وسليمان، وأن هذا الشعب أُجلي مرة أيام البابليين، ومرة ثانية عام 70 بخراب الهيكل للمرة الثانية. وتشتت في شتى الأصقاع وبقي يحافظ على وحدته الدينية والإثنية… وكانت أراضي الشتات تخصُّه وحده فقط، ولا تخصُّ هؤلاء “القلة” الذين وصلوا إليها بمحض الصدفة… لذلك كانت حروب “العائدين” حروباً عادلة، أما مقاومة السكان المحليين العنيفة فقد كانت آثمة“ (ص-12)
وهكذا يبدو الكتاب رحلة في التاريخ اليهودي البعيد يتناول، بنظرة معمقة، أصول وتشكل اليهود كما نراهم اليوم ، وكما ينظر إليهم ساند بصفتهم أبناء مجتمعاتهم وليس أبناء “شعب عتيق” . وعلى النقيض من أعمال “المؤرخين الجدد” الذي عملوا على تفكيك بديهيات “تذويت” التاريخ وفقاً للرؤية الصهيونية ابتداء من العام 1948 أو إلى بداية النشاط الصهيوني في أواخر القرن التاسع عشر، يعود ساند إلى الوراء لتفكيك التصور الأسطوري الصهيونية العنصري لنفي صفة “العرق” عن اليهود، ويبدي استياءه من ميوعة التوصيف العرقي لليهود حيث كانت هناك فترات في أوروبا ” إذا ما قال فيها أحد بأن جميع اليهود ينتمون إلى شعب ذي أصل غير يهودي فإن مثل هذا الشخص كان يُنعت فوراً باللاسامية. أما اليوم فإذا ما تجرأ أحد ما على القول إن الذين يعتبرون يهوداً في العالم (…) لم يشكلوا أبداً شعباً أو قومية، وإنهم ليسوا كذلك حتى الآن، فإننا نجده يوصم في الحال بكراهية إسرائيل”. ولعل مثل هذا الخلط والتضليل يلقي مزيداً من الضوء على تنوع وتعقيد المسار التاريخي لليهود عبر العصور لجهة خضوعهم لمجموعة واسعة من التأثيرات والتقاليد الثقافية والإرث الديني (بشقيه الصوفي والمحافظ) والتطورات الاقتصادية – الاجتماعية للعمران الإنساني الذي عاشوا بين جنباته ( ويخص بالذكر يهود أوروبا الشرقية الأشكناز، الذين ساهموا بفعالية في تشكيل هوية وصورة اليهودي المعاصر)، ومن خلال تصوراته لعدم فصل التاريخ عن التنوع والتغيير المجتمعي المستمر يؤكد على عدم صحة توصيف اليهود بأنهم شعب عاش طويلاً وهو ينتظر الحركة الصهيونية لتنقذه من تشرده وعزلته وشتاته وتؤسس له “وطناً قومياً” مثل باقي الأمم، فهذا التصور البراغماتي بيس سوى أسطورية و “خرافة قومية” معاصرة ظهرت في أوروبا الرأسمالية الاستعمارية.
على عكس ما يراه شلومو ساند وغيره من رواد الهستوريوغرافيا الصهيونية الجدد، يبدو النموذج الصهيوني في فلسطين مثله مثل جسم أميبي شاذ وغريب سوف لن يصمد طويلاً أمام المناعة التاريخية لسكان فلسطين، وهو يرتكز أصلاً على مزاعم إقليمية ذات طابع قومي، تفرض واقعاً يعمد إلى تغيير الكثير من الجوانب والمظاهر الملازمة لليهودي كما عرفتها أوروبا حتى النصف الثاني من القرن العشرين. ولذلك توجهت الصهيونية نحو خلق علاقة تاريخية بين الجاليات اليهودية في العالم وفلسطين باستغلال النصوص التوراتية وتكريسها كنص تاريخي شمولي خطي غير قابل للعكس يضمن ارتباط اليهودي بهذه الأرض بوصفها أرض وعدٍ إلهيٍّ مستمر للعبرانيين القدماء ومن بعدهم لليهود الحاليين -كورثة. وإذا ما اتخذنا الأسفار الخمسة “أسفار موسى” (يشار لها أحيانا باسم التناخ) مرجعاً كما تريد لنا الصهيونية أن نفعل فسوف لن نجد ولو إشارة واحدة إلى أن الرب الذي ظهر لإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى هو رب جميع البشر ( خروج 20:22، تكوين 17 : 7-8 ، خروج 6 : 7 ، خروج 34،14، خروج 20 :3-5) بل هناك تأكيدات على أنه إله العبرانيين بني إسرائيل وذريتهم، كما أن التوراة من جهتها لم تشر إلى وجوب نشر ديانتها ووحدانية الرب بين الشعوب الأخرى، فعلى الرغم من تعريف اليهودية بصفتها “دين توحيدي” يحمل رسالة دينية للبشر كافة، إلا أن هناك إصراراً على اعتبار أن الدين اليهودي جاء حصراً واقتصاراً لهم دون سواهم، وأنهم لم يحولوا اليهودية من دين توحيدي عالمي إلى دين قبلي وشبه عرقي كما يزعم البعض؛ وإنما هو كذلك بالفعل. ومن المعروف أن الحقيقة الدينية -نظرياً- غير معنية بتناقضاتها مع “الحقائق التاريخية” سواء كانت أدلة أثرية أم نصوصاً ووثائق تاريخية أو سواها. وباعتبارها حقائق تقع خارج الزمان والمكان فهي تفترض صحة وصدقية جميع القصص الواردة فيها؛ وستبقى كذلك، ولذلك ستقوم هذه الحقيقة الدينية بتدعيم الادعاء بأن اليهودية دين اقتصاري والرب حكر لقبيلة بني إسرائيل.
ولعل مقولة الشعب اليهودي القديم، على سطحيتها، هي من أخطر ما جاءت به أدبيات الفكر الصهيوني الذي اعتمد عليها في عملية صهر قوية لتشكيل الهويات وخلق التماسك الاجتماعي من خلال تعزيز شعور قوي بماض مشترك (وبالتالي مستقبل مشترك ) عبر زرع “أوهام ” [تاريخية ودينية ] لإضفاء الشرعية على “ماض” محدد – حقيقي أو وهمي – لتشرعن بذلك استعمار البلاد بطريقة لا تقبل التأويل، وبأحقية اليهود في البلاد بأثر رجعي. لذلك يرى ساند، بصفته مواطناً إسرائيلياً من واجبه إنقاذ الهوية الفكرية للإسرائيليين، الأمر الذي يتطلب تنازلات مؤلمة وفلترة قاسية لذاكرة المجتمع وتعقيمها ضد النزعة “الاستعمارية” بما يمنحها مكانها في العالم الحر وتخليصها من مخاطر “النزعة اللاسامية” أو على حد تعبيره “تطبيع الوجود اليهودي في التاريخ وفي الحياة المعاصرة”. ويرى أن مهمة الكتاب تتمثل في دمقرطة الدولة وجعلها جمهورية حقيقية، والوقوف في وجه الأرثوذكسية اليهودية المتشددة. فإذا لم يكن في الماضي شعب يهودي، ولا توجد اليوم أمة يهودية، فقد خلق وجود الاستيطان الصهيوني شعبين في الشرق الأوسط. يوجد اليوم شعب فلسطيني يحارب بضراوة من أجل حريته وبقية وطنه، ويوجد شعب إسرائيلي له لغة وثقافة لا يشاركه فيها أحد من كل هؤلاء الذين يعرفون أنفسهم في العالم كيهود (ص 10، مقدمة ساند للطبعة العربية).
وسوف يعود شلومو ساند في كتاباته اللاحقة ( اختراع أرض إسرائيل.. كيف لم أعد يهودياً) إلى تذكيرنا بتمسكه بجنسيته الإسرائيلية “انتمائه لدولة إسرائيل” رغم تخليه عن يهوديته، وكأنه يحاول الفصل في انتماءاته، والتشديد على عدم ضرورة الترابط العضوي بينهما كما تزعم الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل. ويحدد بسخرية واضحة كيف أن الصهيونية نفسها حتى الآن لم تتوصل بعد إلى تعريف نهائي لليهودي، بمعنى آخر، كن ما شئت في إسرائيل بشرط ألا تكون عربي. وانطلاقاً من هذه الجزئية يوجه ساند في كتابه (اختراع أرض إسرائيل) لوماً للمثقفين العرب لعدم النظر في أن “الاستيطان اليهودي الظالم نجح بالنهاية في “إنتاج شعب جديد على أرض فلسطين: هو الشعب الإسرائيلي.. على حساب السكان المحليين، لكن الذَراري الحاليين لهذا الاستيطان غير قادرين على التخلي عن كل أجزاء الإقليم الذي سيطر عليه آباؤهم بالقوة، بل حتى من خلال العمى الأخلاقي” (ص-19).
لا ينفك ساند يردد أنه ليس صهيونياً في ذات الوقت الذي لا ينكر فيه أنه إسرائيلي ( بمعنى أنه أوروبي أبيض)، وهذه الصفة “كونه إسرائيلي” لا تعني في سياق العالم الحر الذي ينتمي له ساند تهمة أو سبّة حتى لو خدم طياراً في الجيش الإسرائيلي، وربما قام بقتل العديد من الجنود العرب و المدنيين الأبرياء . ولا تعني “أيضا في ذات سياق للعالم الحر” صفة عنصرية فاقعة بقدر ما تعني تخندق صريح وحقيقي ضد كل ما هو “حقيقة تاريخية” وبقدر ما هي “أي صفة كونه إسرائيلي” تطبيق فعلي، حتى لو لم ينطقه علناً، للدوغما الصهيونية التي تقول بأن : فكرة التخلي عن الأرض للفلسطينيين وتحقيق السلام لا يمكن لهما أن يكونا صحيحين معاً، فالأرض هي منحة من الرب لشعب الرب ولا يجوز التنازل عنها؛ أما السلام فلن يتم الوصول إليه حتى يقرّ الفلسطينيون بحقوق اليهود على (و في أي جزء من هذه ) الأرض. وسوف يكون، بالتالي، تهويد الضفّة الغربية ثم الشرقية لنهر الأردن شرط أساسي لتحرير الشعب اليهودي، وهي مهمّة “إلهية” مختلطة مع براغماتية سياسية عبر عنها جوزيف وايتنر ممثّل “الوكالة اليهودية” المسؤول عن الاستيطان، في جريدة “دافار” (29 أيلول1967) حين أكد بأن الحركة الصهيونية توصلت مع بداية الحرب العالمية الثانية في أوائل أربعينيات القرن الماضي إلى نتيجة ترى لا مكان للشعبين (العربي واليهودي) معاً في هذا “البلد” وأنه لتحقيق الأهداف الصهيونية لا بد أن تقام دولة غرب نهر الأردن ليس بها عرب، ولذا كان من الضروري -حسب قوله- “نقل العرب من هنا ومن الدول المجاورة.. نقلهم جميعاً، وبعد انتهاء عملية النقل هذه سيكون في مقدور (الدولة الصهيونية) استيعاب الملايين من إخواننا”.
يشعر ساند بالخذلان الشديد من “دولته” إسرائيل فيقول :”أنا أعي أنني أعيش في واحد من أكثر المجتمعات القائمة في العالم الغربي عنصرية… فما عاد يُحتمل أكثر فأكثر العيش في مجتمع كهذا… ومع ذلك، لن يكون أقل صعوبة أن أسكن في مكان آخر… أنا إسرائيلي، سواء بصيرورتي اليومية أو بثقافتي الأساسية. ولا أعتز بذلك.. حتى أنني في أحيان متقاربة جداً أخجل بإسرائيل”، وعزاؤه في هذه الحيرة القاتلة هو “أن يكون مواطن إسرائيليّ من دون أن يكون يهودي” (للمزيد انظر، كيف لم أعد يهودياً. ص -82). غير أن ما ينبغي ملاحظته هنا في هذه المقاربة “التاريخية” هو أن حقائقها التي تتوسل إثباتها غير نهائية وهي محل شك على الدوام وعرضة للتغيير والتبديل والتأويل والتأويل المضاد، وهي تصطدم مع “الحقيقة الدينية” التي لا تتبدل-وإن تبدلت سياقاتها واختلفت تفسيراتها- والمسألة ليست على درجة من البساطة؛ فالمسألة الفلسطينية كما يراها إدوارد سعيد (وليس كما يراها شلومو ساند) هي صراع “فكرة ” لأن فلسطين ذاتها تقع ضمن فضاء مقولة وفكرة سجالية موضع نزاع بين الصهيونية والفلسطينيين.
ولا يعدو ساند في نهاية المطاف أن يكون أكثر من أكاديمي ” أوروبي أبيض/ غربي على حد قوله هو” يعتمد مقاربة استشراقية ( وإن كانت غير فظة) لفهم الظلم الذي أوقعته “دولته” إسرائيل على مجموع “السكان الأصليين” في فلسطين ، وهو إذ يقر بهذا الظلم وجريمة تهجير السكان من أرضهم وإقامة “دولته” على أنقاض قراهم ومدنهم إلا أنه يتعثر في التصريح عن حل “عادل”.. فهو يقف حائراً أمام حق عودة اللاجئين الذين طردتهم “دولته”.
لنتفق إذن على إيمان ساند بوجود “الشعب الإسرائيلي” في فلسطين، ليس هذا فحسب بل يعطيه حق السيادة والسيطرة، ولا يرى، مثلاً، في الوجود الصهيوني في فلسطين، قبل نحو قرن أو أكثر، جريمة أو استعمار؛ وهو بطبيعة الحال لا يعترف بحق العودة للفلسطينيين، رغم الإجهاد الأدبي الذي استغرقه في تدبيج توطئة الكتاب عن (المحموديْن) و عن (التلميذتين “غير اليهوديتين”).
يهرب شلومو ساند من الحل الحقيقي .. يهرب بعيداً نحو أبواب الأكاديميا.. وهناك سيقف في أروقة جامعة تل أبيب التي أقيمت على انقاض قرية خصص لها فصلاً في كتابه “اختراع شعب إسرائيل” .. سيقف هناك ويتأمل حالماً : “إذا كان ماضي الأمة، في أساسه وجوهره، هو حلم، فلمَ لا نبدأ بالحلم في مستقبلها من جديد، قبل أن يتحوّل إلى كابوس مفزع؟” (إختراع أرض إسرائيل- 97)
إذا كان الشرط الوجودي الفلسطيني عنيداً بالنسبة لإسرائيل وعصياً على الفناء فإن الأرض الفلسطينية بالمقابل أثبتت عناداً أكبر واستعصاء أشد صلابة. وإذن المعركة مركبة؛ فالحرب الحقيقية كما يبدو للعيان ليست على حدود ثابتة وقضايا أمنية ومسائل وضع نهائي بل هي معركة تساءل هذا الشرط الوجودي عن ماضٍ ما زال يعيش بثقله بيننا.
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center