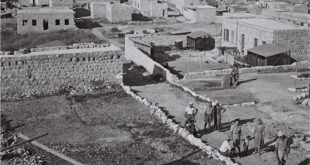الجزء الثاني : في مواجهة الوصاية: نحو استعادة الوعي والسيادة بوصفهما فعلًا تحرريا
يتناول الجزء الثاني ما يُخطط لغزة بعد اتفاق وقف حرب الإبادة، حيث تُفرض وصاية دولية تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني، وإخضاعه للهيمنة الحديثة تحت غطاء الإغاثة والإدارة المؤقتة، وكيفية توظيف الحاجة الإنسانية إلى أداة لضبط المجتمع، وإعادة إنتاج السيطرة على الحياة اليومية، الوعي، والقرار الفلسطيني، في محاولة لتحويل الحق الوطني الفلسطيني إلى ملف إنساني تصوغ شروطه القوى الدولية المتنفذة لإجباره على مقايضة حقوقه السياسية والوطنية باحتياجاته المعيشية.
سوف نستعرض هنا المشهدية التي سبقت إعلان إنهاء حرب الإبادة المشروط بالوصاية الدولية. والمظاهر الرمزية التي سبقت توقيع الاتفاق.
ونموذج” غيتا” للوصاية الدولية على قطاع غزة. الذي يمثل الوجه المدني والناعم للاستعمار والسيطرة. وجوهر التحول من الإبادة الميدانية إلى الإبادة الرمزية باستخدام المساعدات كأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعيد هندسة المجتمع الفلسطيني. إلى جانب أدوات الوصاية، بما في ذلك الخبراء الدوليين، العقود والتمويل المشروط، والمؤسسات الانتقالية، المنظمات غير الحكومية، والتحكيم القانوني الدولي، ويبين كيف تُستخدم هذه الأدوات لتفكيك الفعل السياسي المحلي، الإخضاع، وإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني لإضعاف مناعته، ووقف سعيه لإنهاء الاحتلال.
كما سنقدم بدائل عملية لمواجهة الوصاية وبناء السيادة، تشمل: إعادة بناء المؤسسات الوطنية ذات السيادة، تحرير التمويل، إدارة الموارد محليا، استعادة السيطرة على الوعي والمعنى الثقافي، تحرير المجتمع المدني من التبعية، وتأسيس تحالفات تحررية دولية قائمة على المساواة والشراكة، بما يضمن القدرة على اتخاذ القرار المستقل والحفاظ على المشروع الوطني.
ونستخلص أخيراً سبل مواجهة الوصاية باعتبارها ليست مجرد مقاومة سياسية أو اقتصادية، بل صراع على معنى الإنسان والحرية والكرامة. وما يُخطط لغزة بعد الحرب هو اختبار للقدرة الفلسطينية والعربية على توظيف التضحيات الجسيمة للشعب الفلسطيني للتحرر وبناء سيادة فعلية ووعي مستقل، يرفض إدارة الآخرين لشؤونه، ويعيد للإنسان معنى الإنسان وللتاريخ اتجاهه، وللعالم معيار العدالة.
في مواجهة الوصاية: نحو استعادة الوعي والسيادة بوصفهما فعلًا تحرريا
تحت وطأة الحاجة: خطر الوصاية الدولية على وعي ما بعد الإبادة
في لحظات ما بعد الإبادة، حين تفيض الأرض بالدم، ويُنهك الناس بالحاجة، تدخل الشعوب إلى أخطر امتحاناتها: ليس امتحانَ البقاء الجسدي، بل امتحانَ الوعي.
فحين تُطفأ النيران في الميدان، تبدأ معركةٌ أخرى أكثر خفاء ودهاء، وكما يذكّرنا إدوارد سعيد، “الوعي هو أول ساحات الصراع، لأنه يحدّد من يروي القصة ومن يُروى عنه.”
فالصراع بعد الإبادة ليس فقط على الأرض، بل على حقّ الفلسطيني في أن يروي تاريخه بمعاييره هو، لا بمعايير من يدّعون إنقاذه.
فالمعركة بعد وقف الإبادة تُخاض على أرض الوعي والسيادة، تحت عناوين الرحمة والإنقاذ وإعادة الإعمار. وهنا تولد الوصاية، في هيئة مجلس سلام أمريكي وسلطةٍ انتقاليةٍ دولية.
من الإبادة إلى الوصاية – حين تتبدّل الأدوات ويبقى المشروع
تبدو لحظة “ما بعد الحرب” في ظاهرها نهايةَ المأساة، لكنها في جوهرها استمرارٌ لها بأدواتٍ جديدة. فالإبادة، حين تفشل في قتل الجسد، تحاول قتل الوعي، وما لم يُستكمل بالمحرقة العسكرية يُستأنف بالوصاية الإنسانية.
إنها المرحلة الثانية من المشروع ذاته:
تحويل الضحية إلى تابعٍ، والمقاومة إلى إدارةٍ، والحرية إلى طلبٍ مرهونٍ بالموافقة الدولية. وهنا تتجلى ما وصفه مالك بن نبي بـ“القابلية للاستعمار”، حين يفقد المجتمع مناعته الداخلية فيقبل إدارة الخارج لشؤونه باسم المصلحة.
فالوصاية ليست فقط فعلًا يُفرض من الخارج، بل حالة وعي تُستدرج من الداخل.
من هنا، تصبح الوصايةُ الوجهَ المدنيَّ للعنف الاستعماري، امتدادًا للعقل الذي صنع الإبادة ثم جاء ليُرمم آثارها، كي يحتفظ بالسلطة الأخلاقية على تعريف الضحية ومعناها.
إنها ذروةُ ما سمّاه فانون “الإنسان المقهور الذي يُعاد إنتاج قهره باسم إنقاذه”،
وما رآه ماركس في جوهر الرأسمالية حين تُحوِّل المعاناةَ إلى سلعةٍ جديدة. فالحداثة التي وعدت بالتحرر من الطبيعة، قادت إلى إخضاع الإنسان لآلتها.
وحين انفجرت تناقضاتها في غزة، لم تُراجع ذاتها، بل نقلت المعركة من الميدان إلى الإنسان: من احتلال الأرض إلى إدارة الحياة، ومن السيطرة على المكان إلى تنظيم المعنى.
لكنّ غزة، كما كانت في الحرب، قادرةٌ أن تكون في الوصاية أيضًا فضاءً للمقاومة المعنوية. فهي لم تعد مجرّد جغرافيا محاصرة، بل رمزًا كونيًا يُعيد تعريف الحرية في زمن الحداثة المتوحّشة.
والمعركة الآن ليست بين الفلسطيني والاحتلال فقط، بل بين الإنسان ومنظومة الإبادة المعولَمة التي تريد إعادة صياغة العالم على مقاس السوق والهيمنة.
إنّ مواجهة الوصاية، إذن، هي مواجهةٌ مع جوهر النظام الدوليّ نفسه، مع بنيته الأخلاقية التي تمنح لنفسها الحقّ في تصنيف الشعوب وتوزيع الكرامة وفق المعايير السياسية والاقتصادية.
وحين يرفض الفلسطيني أن يُدار، فإنه لا يدافع عن وطنه فحسب، بل عن المعنى الإنسانيّ للحرية ذاتها.
فالتحرّر هنا لم يعد مطلبًا وطنيًا فقط، بل سؤالًا كونيًا حول مصير الإنسان في عالمٍ فقد مرجعياته الأخلاقية.
إنه نداءٌ من تحت الركام، يُذكّر البشرية بأن الكرامة لا تُمنَح من مجلس، ولا تُقاس بميزان المعونات، بل تولد من إرادة الإنسان أن يكون حرًّا رغم العالم كلّه.
هكذا، ما بعد الإبادة ليس نهايةَ التاريخ، بل بدايته الحقيقية،
وما بعد الوصاية ليس إدارةَ مرحلة، بل معركةَ المعنى الأخيرة بين عقلٍ يُدير الموت باسم الإنسانية، ووعيٍ يولد من رحم الكارثة ليعيد للإنسان اسمه، وللحرية معناها، وللتاريخ اتجاهه.
أولًا: المشهدية التي سبقت إعلان الوصاية
قبل أن تُعلن الوصايةُ رسميًّا، تبدأ بتصنيع رموزها وصورها التمهيدية. فالمشهد الذي تصدّر الشاشات ليس بريئًا: كلُّ شيءٍ يُعاد ترتيبه ليُقال: لقد انتهت الحرب، وبدأ السلام.
بدأ رسول السلام، دونالد ترامب – الذي تحمل مشقة السفر إلى المنطقة المتفجرة لإعلان وقف حرب الإبادة – زيارته السلميّة للمنطقة بخطاب في الكنيست الإسرائيلي. افتتح الجلسة قادة المستعمرة الاستيطانية الغربية الصهيونية، سلطة ومعارضة، وتعمدوا في كلماتهم الطويلة، التي أرهقت الضيف، إظهار كيف تفوّق التلاميذ على أساتذتهم الأنجلو ساكسون، وشكروا دعم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها الأكثر ولاءً ووفاءً لإرث أسلافه، وتعهدوا باستكمال المهمة سلما أو حربًا.
وبدوره ذكرهم ترامب، الذي جاء كما قال، لحل صراع ثلاثة آلاف قرن، بخطاب تعمّد فيه الإطالة للإمعان في إذلال قادة النظام العربي والإسلامي والدولي المنتظرين حضور المخلص، رسول “الإبراهيمية الحديثة”، الذين احتشدوا في شرم الشيخ ليشهدوا توقيع اتفاق وقف حرب الإبادة في قطاع غزة المشروط بوصاية دولية لمجلس السلام، الذي سيرأسه شخصيا رغم مشاغله الكونية.
فأمعن في تذكير إسرائيل حكومةً وشعبًا بفضل بلاده وفضله الشخصي، ودوره في دعم حرب محو الشعب الفلسطيني تسليحًا، وتمويلًا، وحمايةً من نفاذ الاتفاقيات والقوانين الدولية وقرارات مؤسسات العدالة الدولية.
ولم ينس الثناء على فريقه المتميز الذي أشرف على صياغة التفاصيل، وخص بالثناء القادة العسكريين، وخبراء الصفقات ويتكوف وابنته وصهره “العبقري” كوشنير، الذي صاغ خطة استملاك غزة وتحويلها إلى “ريفيرا الشرق الأوسط ” بعد تدميرها واستئصال من تبقّى من سكانها، وتوزيعهم على دول الجوار العربية، وعلى الدول الإسلامية الملزمة بتوطينهم، طوعًا أو كرها.
ولم ينس في ختام خطابه السخرية من منتظريه في شرم الشيخ، فتوقع أن يكون الأثرياء منهم قد سئموا الانتظار وغادروا بطائراتهم العملاقة الخاصة، ولن يتبق بانتظاره سوى الفقراء. وعندما استقل الطائرة الرئاسية ووصل شرم الشيخ متأخرا عدة ساعات، اصطحبته ست طائرات حربية من الدولة المضيفة في جولة فوق أرض الكنانة.
وبعد انهاء اجتماعه الثنائي مع مضيفه المصري، لم يتفاجأ بأن الجميع ما يزالون في طابورانتظار لقطات منفردة مع المخلص، وأُضيف إليهم رئيس الشعب المباد والبلد الذي بات ركاما. كيف لا وجميعهم يدركون أنهم في مركب واحد، وأنّ مصيرهم مترابط.
ثم بدأ يستقبل الشهود تباعا ويسمح لهم بالتقاط صور تذكارية معه ويوزّع الابتسامات، ويعد ب” السلام وبناء المستقبل”.
لكنّ ما يُبنى هنا ليس سلاما، بل سردية جديدة عن الضحية. فبدل أن تكون رمزًا للمقاومة، تُقدَّم كموضوع للشفقة، كجسد عليل يحتاج إلى رعاية دوليّة. يُسحب منها معنى البطولة، ليُستبدل بمعنى الحاجة، ويُعاد تشكيل وعيها كي ترى في وصيّها المنقذَ لا المُسيطر.
هكذا تبدأ الوصاية قبل توقيع الاتفاقيّات: في اللغة، في الصورة، في الوعود الأولى التي تُقدَّم أمام الكاميرات. إنها عمليّةُ إعادةِ هندسةٍ للوعي، تستبدل منطقَ الحرية بمنطق الإدارة، ومنطقَ السيادة بمنطق “المسؤوليّة الدوليّة”.
ثانيًا: مجلس الوصاية
تتولى المهام التنفيذية بعثة دولية، أو سلطة انتقالية صمّمها كوشنر صهر الرئيس، تسمى السلطة الانتقالية أو هيئة إعادة الإعمار، يقودها طوني بلير مع ثلة صغيرة من كبار المقاولين الدوليين، تتقدّم بخطابٍ إنسانيٍّ، ظاهره الرحمة، وباطنه إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني والعربي والاسلامي على مقاس نظام الحداثة المهيمن، الذي رعى وموّل الإبادة، والنظام الدولي الذي صمت ثم جاء ليرعى ما بعدها.
تحت وطأة الحاجة، يُعاد تعريف الكرامة، وتُستبدل السيادة بالمساعدات، والمقاومة بالحوكمة، والحق في التحرير بالحق في الإغاثة.
هكذا تتحوّل غزة من رمزٍ للتحرر الإنساني إلى حقل تجارب لإدارة الأزمات، وتُستدرج القضية الفلسطينية إلى نموذج جديد من الاستعمار الإداري، ليس بالسلاح، بل بالملفّات، وليس بالمدرعات، بل باللجان والخطط والتمويل المشروط.
إن أخطر ما في هذه اللحظة ليس ما يُبنى على الأرض، بل ما يُهدم في الوعي: أن يتحوّل الفلسطيني من فاعل في التاريخ إلى “موضوعٍ للوصاية”، ومن حامل لمشروع التحرير إلى “مستفيد من برامج التعافي”.
إنّ “غيتا” – بصيغتها المعلنة أو المضمرة – كما تم بيانه في الجزء الأول من المقال، تظهر أن السلطة الانتقالية ليست مشروعًا لإعمار غزة بقدر ما هي محاولة لإعادة هندسة الوعي الفلسطيني بعد أن فشلت آلة الإبادة في كسره.
وما يبدو “ترتيباتٍ انتقالية” هو في جوهره نظام ضبطٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ وثقافيٍّ يستهدف تفريغ النصر المعنوي من مضمونه، وتحويل المقاومة إلى إدارة، والتحرر إلى وظيفة.
فالمعركة الحقيقية الآن ليست بين الدمار والإعمار، بل بين الحرية والكرامة والوصاية،
بين أن تُبنى غزة بيد أصحابها، أو تُعاد صياغتها على يد من أبادوها.
وهنا يبدأ السؤال الأخطر: هل يمكن لشعبٍ خرج من تحت الركام أن يصون وعيه من إعادة الاحتلال بثياب إنسانية؟
ثالثا: الوصاية كاستمرار للهيمنة الاستعمارية الحديثة
منذ القرن التاسع عشر، لم تكن الوصاية الدولية سوى الوجه “القانوني” للاستعمار بعد أن غيّر شكله ولغته.
فهي آلية يُعاد من خلالها إنتاج السيطرة تحت مسمى “المسؤولية الدولية” أو “إدارة المرحلة الانتقالية”، وكما يؤكد مهدي عامل، “الاستعمار لا يرحل فعلاً إلا حين تُفكَّك آلياته البنيوية في الاقتصاد والسياسة والثقافة.” فالوصاية، بما تفرضه من بنى تمويلية وإدارية، ليست سوى إعادة إنتاج لهذه الآليات بأسماء جديدة
حيث تنتقل السلطة من يد المحتل العسكري إلى يد المؤسسات الأممية أو التحالفات الإقليمية – دون أن يتغير جوهر الهيمنة، بل فقط تتبدّل أدواتها وخطاباتها.
فالحداثة الغربية، التي شرعنت الاستعمار باسم “تمدين الشعوب المتخلفة”، هي نفسها التي تشرّع اليوم الوصاية باسم “إعادة تأهيل المجتمعات الخارجة من النزاع”.
الغاية واحدة: تجريد الشعوب من حقّها في السيادة باسم مصلحتها، وتحويل التحرر إلى “عملية خاضعة للمراقبة والإشراف”.
في السياق الفلسطيني، تأخذ هذه الهيمنة شكلاً أكثر تعقيدًا، لأن المشروع الصهيوني نفسه هو النسخة الأكثر عنفًا من الحداثة الاستعمارية.
فحين فشلت الإبادة في القضاء على الإنسان الفلسطيني جسدًا، يُستكمل المشروع بمحاولة احتلال وعيه وتنظيم حياته اليومية عبر إدارةٍ دولية محايدة شكلًا، استعمارية مضمونًا.
إنّ فكرة “غيتا” لا تنفصل عن هذا النسق، فهي تحويلٌ لقضية الشعب الفلسطيني إلى معطى إداري يخضع للرقابة والتمويل المشروط.
بهذا المعنى، تشكّل الوصاية الدولية استمرارًا ناعمًا لفعل الإبادة، لأنها تنزع عن الفلسطيني قدرته على تقرير مصيره لحساب “الخبراء”، و” اللجان”، و” المبعوثين”، وتعيد تعريف الفلسطيني بوصفه “حالة إنسانية” لا “قضية تحررية”.
إنها إعادة إنتاج لفكرة الاستعمار كوصاية حضارية، لكن بلغةٍ جديدة: التنمية بدل الاستعمار، الدعم بدل السيطرة، الحوكمة بدل الاحتلال.
وهكذا تُختزل المأساة إلى إدارة أزمة، وتُحوّل فلسطين من بؤرة نهوض إنساني إلى ملفٍّ إنساني قابل للتفاوض والتمويل.
فالتحرر الحقيقي لا يبدأ بإعادة الإعمار، بل برفض أن تُدار غزة بوصفها موضوعًا دوليًا لا ذاتًا وطنية، وبالوعي أن كل شكلٍ من أشكال الوصاية هو في جوهره إلغاءٌ للسيادة وتمديدٌ لزمن الهزيمة ولو بوسائل ناعمة.
رابعا: من الإبادة الميدانية إلى الإبادة الرمزية – كيف تتحول المساعدات إلى أداة للهيمنة
حين يتبدّل سلاح القتل المباشر إلى حزمةٍ من مساعداتٍ دولية، لا تختفي العنفية، بل تتنكّر. تتحوّل آليات الإغاثة وإعادة الإعمار إلى وسائل دقيقة لإعادة هندسة المجتمع والسياسة والذاكرة. فـ«المساعدة» في زمن الوصاية لا تأتي محايدة: تأتي مشروطة، ممنهجة، ومؤطرة بلغةٍ فنية وقانونية تستبعد البعد السياسي لمطالب الشعب. وهنا يتحقّق ما وصفه جورج طرابيشي، “العقل المقهور يعيد إنتاج قاهره في داخله”، فيتحول الخطاب الإنساني إلى قناعٍ لإعادة إنتاج السيطرة ذاتها.
تتحقق الإبادة الرمزية عبر آليات عدة مترابطة:
- التشويه الإدراكي عبر الطرح الإنساني: اختزال القضية إلى معانٍ إنسانية ضيقة – مياه، مأوى، غذاء، دواء – مع إقصاء المطالب السياسية الأساسية (الحق في الحرية، العودة، إنهاء الاحتلال). هذا الاختزال يحوّل الفلسطيني من صاحب حقّ وفاعل تاريخي إلى «مستفيد إنساني» يُقيَّد بجداول زمنية وشروط تمويلية.
- الشرطية المالية والسياسية: تفرض الجهات المانحة شروطًا إدارية وقانونية (شفافية، رقابة، شراكة مع القطاع الخاص، إلخ) تبدو تقنيًا محايدة لكنها في حقيقتها أدوات للهيمنة الاقتصادية والسياسية، تقوّض قدرات المؤسسات الوطنية وتعزّز تبعية النخب المحلية للاعتمادية الخارجية.
- تقنية الاختزال والتقييس (البيروقراطية الفنية): التحكّم عبر مشاريع قابلة للقياس والمؤشرات، حيث تُسجن حاجة الإنسان داخل مؤشرات نجاح قابلة للتقرير – بينما تُهمل العمليات السياسية التي يصعب قياسها: الكرامة، التاريخ، الذاكرة، السيادة.
- تجريف الذاكرة والرموز: عبر تمويل مشاريع «ثقافية» و«ترميمية» تُعاد فيها كتابة سردية ما تمّ تدميره، أو يُعاد تأطير المقاومة كظاهرة عبثية تحتاج إلى «إزالة الآثار السلبية» بدلاً من الاعتراف بشرعية مواجهة الاحتلال.
- إعادة تسليع الفضاء العام: فتح سوق إعادة الإعمار أمام شركات دولية أو إقليمية، ما يحوّل البنية إلى مشروع استثماري يخضع لقانون السوق أكثر منه لحاجات الناس، ويؤسّس لاقتصاد يعتمد على عقود خارجية تُكرّس علاقة تبعية طويلة الأمد.
- إفشال الفعل السياسي المحلي: إنشاء آليات حكم انتقالية أو مجالس مدنية تُشرف عليها بعثات خارجية، تمنح شرعية إدارية موقتة لكنها تقضم من قدرة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية على اتخاذ قرارات سيادية دائمة.
- التطبيع الإداري والقانوني: فرض أطر قانونية وتنظيمية تستبدل إطار الحقّ بالقواعد التشغيلية، فتُصبح الخلافات مع الوصاية مسائل إجرائية لا حقوقية، ويُمحى البُعد الأخلاقي للمطالبة بالتحرر.
النتيجة العملية لهذا التحوّل: مجتمع يُعاد تشكيله ليكون قابلاً للإدارة، لا مقاوما للتحرّر، ذاكرة تُعاد كتابتها بصيغة تُريح المانح وتُخضع المقاومين لتقييمات فنية، ونخب محلية، تكنوقراط، تُستدرج داخل دوائر الاعتماد فتفقد استقلالية القرار. وهذا كله يترتب عليه أثر طويل الأمد: تفكيك استمرار القدرة الوطنية على المطالبة بالحقوق الوطنية والسياسية، وتحويل الانتصار المعنوي إلى مشروع إداري محدود التأثير.
لمواجهة هذا المسار، لا يكفي الرفض الأخلاقي وحده، بل يلزم استراتيجية مزدوجة:
٠ رفض الشروط التي تسلب السيادة،
٠ وتقديم مقترحات بنّاءة لإدارة الاحتياجات بآليات سيادية شعبية، مثل هندسة تمويلية بديلة، ولجان إعادة إعمار بقيادة محلية ذات صلاحيات حقيقية، وآليات رقابة دولية تقتصر على الشفافية دون فرض الأجندات، وحماية للذاكرة والرواية الوطنية كجزء لا يتجزأ من عملية الإعمار.
خامسا: أدوات الوصاية – من الخبراء إلى العقود: الآليات والمؤسسات
الوصاية لا تدخل بالدبابات، بل بالوثائق. تبدأ ببعثة “فنية”، وتتطور إلى هيئة “انتقالية”، ثم تُكرَّس بقرارات أممية واتفاقيات تمويل مشروطة.
وهكذا يتسلّل شكل جديد من السيطرة لا يُمارَس باسم الاحتلال، بل باسم الإدارة الرشيدة والحوكمة الدولية.
تعمل منظومة الوصاية عبر شبكة معقدة من الأدوات والوسطاء، تعيد ترتيب الفضاء السياسي والاقتصادي والثقافي في المجتمع المستهدف، بحيث تفقد المقاومة قدرتها على المبادرة، وتتحول السلطة المحلية إلى منفذ للقرارات الدولية.
- الخبير كوكيل للهيمنة
يبدأ الأمر بالخبير: ذلك الذي يتحدث لغة الأرقام والمشاريع والإصلاح المؤسسي.
الخبير هو الجندي الجديد للهيمنة، سلاحه التقرير، وميدانه الاجتماع التقني، وذخيرته المفاهيم البيروقراطية التي تخفي السياسة وراء المصطلح.
باسمه يُعاد تعريف الأزمة، وبمعاييره تُقاس الكفاءة والشرعية.
يتحوّل الفعل الوطني إلى مشروع قابل للتمويل، والمقاومة إلى خطر على الاستقرار.
وهكذا يُعاد إنتاج السيطرة عبر جهاز إداري يملك السلطة دون أن يتحمّل المسؤولية السياسية.
- العقود والتمويل المشروط
التمويل ليس مساعدة بريئة، بل عقد سيادة غير مكتوب.
كل منحة تحمل في داخلها “أجندة” مضمرة: شروط للإنفاق، آليات مراقبة، مؤشرات أداء، ومعايير قبول وإقصاء.
يُعاد توزيع الموارد بحيث يُربَط المجتمع الفلسطيني بمنظومة الاقتصاد النيوليبرالي العالمي – فينكمش الإنتاج المحلي، وتتراجع استقلالية القرار، وتُخلق طبقة بيروقراطية – اقتصادية تتغذى على التمويل الخارجي وتدافع عن استمراره كشرط لبقائها.
بهذا، تصبح المساعدات بديلاً عن السيادة، ووسيلة لضبط التوجهات السياسية عبر الاقتصاد.
- المؤسسات الوسيطة: السلطة بوصفها إدارة
تُنشأ في ظل الوصاية مؤسسات “انتقالية” تتولى إدارة شؤون الناس تحت مظلة دولية أو إقليمية. لكن هذه المؤسسات، مهما بدت وطنية الشكل، تُصاغ صلاحياتها وحدودها من الخارج، وتُقاس فعاليتها بمدى توافقها مع “المعايير الدولية”، لا بمدى تعبيرها عن الإرادة الشعبية.
فتتحول السلطة من أداة للتحرر إلى إدارة للمكان والسكان، تُمكّن النظام الدولي من ممارسة سيطرته دون تكلفة الاحتلال المباشر.
إنها الاستعمار عبر التفويض: الاحتلال بالوكالة.
- المنظمات غير الحكومية كشبكة مراقبة ناعمة
تغزو المنظمات الدولية والمحلية ساحة العمل الاجتماعي والثقافي تحت شعار “تمكين المجتمع المدني”.
لكن هذا التمكين غالبًا ما يعني تجزئة الفعل الوطني إلى مشاريع صغيرة معزولة، تُدار بمعايير الممول، وتُخضع الوعي الجمعي إلى خطابات “التسامح” و” المصالحة” و” الحياد الإنساني”، التي تفرغ الذاكرة من بعدها المقاوم.
تتحول هذه المنظمات إلى نظام عيون ناعم يراقب اتجاهات الناس، ويقيس “مؤشرات الاستقرار”، ويقدّم البيانات التي تُستخدم لتكييف السياسات الدولية على الأرض.
فبدلاً من أن تكون أداة للمجتمع ضد الدولة، تصبح في منظومة الوصاية أداة للنظام الدولي ضد السيادة.
- التحكيم القانوني الدولي
يُستبدل النظام القضائي الوطني بمنظومات تحكيم خارجية، تُبرّر تدخل المؤسسات الدولية في شؤون العدالة والمساءلة.
بهذا تُصبح السيادة القانونية نفسها موضوعا للتفاوض، ويُفتح الباب لتدويل كل نزاع داخلي، حتى يصبح الوطن ساحة مفتوحة لتدخل “الخبراء القانونيين” الدوليين الذين يحدّدون مفهوم الجريمة والعدالة وفق معاييرهم.
في مجموع هذه الأدوات، لا تُمارس الوصاية كقوة فوقية فحسب، بل كبيئة كاملة تحيط بالإنسان الفلسطيني، تعيد تعريف حاجاته، وتحدد مساحات حركته، وتمنحه حق البقاء مقابل التنازل عن حق التحرير.
إنها شكل متطور من الاستعمار الإداري الذي يحكم باسم “الإنسانية”، بينما يعيد ترتيب العالم على مقاس الأقوياء.
سادسًا: تحت وطأة الحاجة: حين يصبح البقاء أداة للوصاية
ما بعد الإبادة ليس زمنًا للراحة، بل مرحلة جديدة من المعاناة المادية والإنسانية.
فالجوع لا يقلّ فتكًا عن القصف، والخوف لا يقلّ عن الحصار.
إنها معركة البقاء اليومي، حيث تُختزل الكرامة الإنسانية في سؤال المأكل، والملبس، والمسكن، والعلاج.
من بين الركام، ينهض الشعب ليواجه واقعًا من الدمار الشامل والبؤس الإنساني:
ركام يغطي البيوت والمدارس والمستشفيات، جثث لم تُنتشل بعد، أطفال بلا مأوى،
وغذاء ودواء يُداران كسلعتين نادرتين تخضعان لحسابات سياسية وأمنية.
يتحوّل “الإنساني” هنا إلى أداة ضبط جديدة، ويُستخدم الاحتياج المعيشي كذريعة لتمديد السيطرة تحت شعار “الإغاثة” و“الاستقرار”.
وفي ظل هذا الواقع، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا:
كيف يمكن للشعب أن يطالب بالسيادة بينما لا يجد طعام يومه؟
لكن الأخطر أن يُختزل الإنسان في حاجته، وأن تتحول الكارثة إلى فرصة لبناء نظام وصاية دولي باسم الإنقاذ.
فحين يُدار الجوع بالمساعدات المشروطة، ويُدار الخوف بالوجود العسكري “الحمائي”، تبدأ المرحلة الأخطر: الوصاية تحت غطاء الإنسانية.
إنها لحظة انزلاق تدريجي من “الإغاثة المؤقتة” إلى “الإدارة الدائمة”، حيث يُعاد تعريف الفلسطيني لا كمواطن له حق، بل كنازح له حصة في برنامج.
ولذلك، فإن إنقاذ الإنسان من الجوع والمرض والبرد ضرورة أولى لا تقبل النقاش، لكنها لا تكتمل إلا حين يُستعاد حقه في إدارة إنقاذه بنفسه. فالمطلوب ليس الخبز فقط، بل الخبز الذي لا يُشترى بثمن الكرامة، ولا المأوى الذي يُبنى على أنقاض السيادة.
سابعًا: مواجهة الوصاية: من نقد التبعية إلى بناء سيادة الوعي والقرار
بدائل السيادة والتحرر الذاتي
بعد كشف أدوات الوصاية، يصبح السؤال المركزي: كيف يحوّل الفلسطيني معاناته ووعيه إلى سيادة فعلية وقرار مستقل؟
المطلوب ليس رفض العالم أو المساعدات الدولية، بل إعادة تعريف العلاقة معه على أساس الحقوق الوطنية والقدرة الذاتية، وليس على شروط المانحين أو إملاءات السلطة الخارجية. كما قال محمد عابد الجابري، “التحرر يبدأ بتحرير العقل من التبعية للآخر، لا بالقطيعة معه.” فالسيادة لا تعني العزلة، بل الوعي النقدي بالعلاقة مع العالم على أساس الندية لا التبعية
ا. إعادة بناء المؤسسات الوطنية ذات السيادة
- إصلاح منظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية لتصبح جهات شرعية تمثل الشعب فعليًا، لا أذرعًا للوصاية أو مشاريع المانحين.
- إنشاء آليات رقابية محلية مستقلة تضمن شفافية إدارة الموارد والمشاريع دون فرض أجندات خارجية.
- توحيد جهود المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية لتعمل كهيكل بديل للوصاية، يضمن مشاركة المجتمع في صنع القرار.
2.تحرير التمويل وإدارة الموارد
- تطوير شبكات تمويل محلية وقطاعية بديلة تقلل الاعتماد على المانحين الدوليين المشروطين.
- استثمار الموارد المحلية – مثل الأراضي، المهارات، المشاريع الصغيرة – لإعادة إعمار قطاع غزة على قاعدة الاستقلال المالي والسياسي.
- إنشاء صناديق محلية للطوارئ والإعمار تُدار بشفافية وتخضع لمساءلة المجتمع مباشرة.
.3استعادة السيطرة على الوعي والمعنى
- إنتاج خطاب ثقافي وتعليمي وإعلامي فلسطيني حر، يروي القصة الفلسطينية من منظور الضحية الفاعلة لا من زاوية “المستفيد من المساعدة”.
- حماية ذاكرة الشعب والرموز الوطنية من التغييب أو التجميد تحت شعارات “الحياد الإنساني”.
4 . تحويل التعليم والتربية والثقافة إلى أدوات لتعزيز وعي السيادة والكرامة في مواجهة أي تدخل خارجي.
5 .تفعيل المجتمع المدني المقاوم للوصاية
- إعادة توجيه مؤسسات المجتمع المدني للعمل ضمن المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن برامج التمويل المشروط التي تقسم النشاط الشعبي إلى مشاريع صغيرة.
- تكوين شبكات محلية وإقليمية للتنسيق المدني المستقل، بما يخلق ضغوطًا على الهيمنة الدولية دون التضحية بالحق الفلسطيني في تقرير مصيره.
- التحالفات التحررية العالمية
- الانفتاح على التضامن الدولي من موقع شريك متساوٍ، وليس من موقع تابع.
- تأسيس تحالفات مدنية عالمية تدعم حقوق الإنسان والسيادة الوطنية، لا مشاريع التبعية أو “الإغاثة المشروطة”.
- استخدام هذه التحالفات لفضح الاستعمار الحديث، وإبراز شرعية الحقوق الفلسطينية عالميًا من منظور العدالة وليس القوة.
ثامنًا: من نقد التبعية إلى بناء سيادة الوعي والقرار
كل هذه البدائل تشترك في قاعدة واحدة: السيادة تبدأ من القدرة على اتخاذ القرار بنفسك، قبل أي قرار دولي أو مساعدات خارجية.
البقاء على قيد الحياة (الغذاء، الدواء، السكن، إزالة الركام) هو شرط أساسي، لكن تحرير الإنسان من التبعية وإعادة بناء المؤسسات المستقلة هو الفعل الذي يحوّل غزة من مكان تحت الوصاية إلى فضاء سيادة وحرية حقيقية.
إن مواجهة الوصاية لا تعني رفض المساعدات أو الانغلاق أمام العالم، بل تعني أولًا تحرير شروط العلاقة مع العالم من موقع التابع إلى موقع الندّ.
فالخطر لا يكمن في التعاون الدولي، بل في تحويله إلى وصاية تُدار تحت ذريعة العجز الوطني.
ومن هنا تبدأ المواجهة على مستويين متكاملين: الوعي والسيادة.
- سيادة الوعي – تحرير المعنى من قبضة المانح
أول أشكال المقاومة في زمن الوصاية هو المعرفة.
يجب تفكيك الخطاب الذي يصوغ المانح الدولي بوصفه منقذًا، والفلسطيني بوصفه عاجزًا.
فهذا الخطاب يعيد تعريف الذات الوطنية على أساس الحاجة لا على أساس الحق، ويؤسس لوصاية رمزية أخطر من أي احتلال مادي.
إن إعادة تعريف المفاهيم – “الإعمار”، “المساعدة”، “الاستقرار”، “الحياد الإنساني”، “المرحلة الانتقالية” – هي المعركة الأولى للسيادة الفكرية.
فمن يملك تعريف المفاهيم يملك توجيه الواقع.
يجب أن تتحرّر اللغة الفلسطينية من القاموس الأممي الذي جرّدها من تاريخها، وأن تستعيد مفرداتها الأصلية: تحرير، عودة، كرامة، سيادة، حق، ذاكرة، مقاومة.
بهذا فقط يمكن حماية الوعي من إعادة الاستعمار عبر الخطاب.
- سيادة القرار – رفض التبعية البنيوية
السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل منظومة قدرة على اتخاذ القرار المستقل.
ولن تتحقق إلا عبر تفكيك بنية الاعتماد السياسي والأمني والمالي والإداري على الخارج.
يتطلب ذلك بناء بدائل تمويلية داخلية تعتمد على طاقات المجتمع وموارده، وإقامة شراكات إقليمية متكافئة، لا مشروطة ولا مرهونة.
كما يجب أن تُعاد هيكلة المؤسسات الوطنية على قاعدة الشفافية والمسؤولية الشعبية، لا على إملاءات المانحين.
فالاستقلال المالي هو شرط الاستقلال السياسي، والسيادة تبدأ من الاقتصاد لا من الخطاب الدبلوماسي.
- تحرير الفعل المدني من الاستتباع
لا بد من استعادة المجتمع المدني من قبضة المنظمات الممولة.
يجب أن تُبنى مؤسسات المجتمع الأهلي بوصفها أذرعًا للمجتمع لا امتدادًا للتمويل الخارجي.
ويجب أن تُعاد صياغة أولويات العمل الأهلي في ضوء المشروع الوطني، لا في ضوء أجندات “الممولين”.
فالمجتمع المدني، حين يتحرر من التمويل المشروط، يصبح الضمانة الأخيرة ضد الوصاية، ويستعيد دوره التاريخي في الدفاع عن السيادة والمساءلة الشعبية.
- المقاومة الثقافية والمعرفية
المعركة ليست سياسية فقط، بل هي صراع على الوعي والذاكرة.
يجب مواجهة الوصاية على مستوى الخطاب الثقافي والإعلامي والتربوي، من خلال إنتاج معرفة فلسطينية حرّة تروي الحكاية بلسانها، لا بترجمة المانحين.
إن مقاومة النسيان، وإعادة كتابة التاريخ الفلسطيني من منظور الضحية الفاعلة، لا المستغرقة في الألم، هو فعل سيادي بامتياز.
فمن يحتكر سرد الحكاية يملك توجيه المستقبل.
- بناء التحالفات التحررية العابرة للحدود
الوصاية مشروع كوني، ولا يمكن مقاومته إلا بوعي كوني مضاد.
يجب الانفتاح على حركات التضامن العالمية، لكن ليس بوصفها مراكز شفقة، بل كشركاء في مشروع تحرري إنساني يعيد تعريف العدالة من منظور الشعوب. كما قال عبد الكبير الخطيبي، “من يملك ذاكرته يملك مستقبله.” فالتحالفات الحقيقية لا تقوم على المساعدات، بل على تبادل الذاكرة والكرامة والمعنى.
فما كشفته غزة من زيف المنظومة الدولية يمكن أن يتحول إلى تحالف معرفي وأخلاقي عالمي يعيد بناء الخطاب الإنساني على أسس المساواة الحقيقية بين البشر
تاسعًا: نحو وعي ما بعد الوصاية
إن أخطر ما تفعله الوصاية أنها تحوّل القضية إلى إدارة، والكرامة إلى برنامج تمويلي.
ومواجهتها تبدأ حين يستعيد الفلسطيني والعربي حقه في تعريف ذاته ومصيره دون وسيط. ذلك أن الاستقلال لا يتحقق حين يرحل المحتل فقط، بل حين يتحرر الوعي من التبعية، والقرار من الخوف، والإنسان من الوصاية.
عاشرًا: من الركام إلى السيادة: ولادة وعي التحرر
لقد بدأت غزة كأرض منسية تحت وطأة الحروب والإبادة، تحمل على جسدها دماء الأبرياء، وعلى وعيها سؤال البقاء والكرامة. لكن ما بعد وقف حرب الإبادة لن يكون نهاية الصراع، بل بداية مرحلة جديدة أخطر وأكثر دقة، حيث تتنكر الهيمنة بصور إنسانية، وتحاول السيطرة على الحياة والوعي تحت غطاء الإغاثة والإدارة المؤقتة.
تحت وطأة الحاجة، يتحقق الإنسان الفلسطيني: بين الجوع والخوف، بين إزالة الركام وانتشال الجثث، وبين تأمين الغذاء والدواء والسكن، يولد وعي المقاومة اليومي.
فامتلاك القدرة على البقاء هو أول خيط للسيادة، وبدون هذه القدرة يصبح أي حديث عن الحرية مجرد شعار بلا مضمون.
إن مواجهة الوصاية ليست مجرد عمل سياسي، بل صراع على معنى الإنسان والحرية والكرامة. فكل خطوة لإدارة الحياة بكرامة، كل مدرسة تُبنى، كل مؤسسة تُستعاد، هي فعل مقاومة وعي وسيادة.
وبهذا، تصبح غزة ليس فقط موقعًا للجغرافيا والدم، بل فضاءً لولادة جديدة للإنسان والحرية:
إنسان قادر على تقرير مصيره، على حماية ذاكرته، على إعادة كتابة التاريخ بيده، وعلى رفض أن يُدار من الخارج باسم الإنسانية أو المصلحة الدولية.
فما بعد الإبادة ليس زمنًا للبكاء على الركام، بل زمنًا لبناء وعي جديد، يدرك أن إعادة الإعمار الحقيقية هي إعادة بناء الإنسان في سيادته وكرامته، وأن التحرر من الوصاية هو الشرط الأول لولادة فلسطين الجديدة – فلسطين التي لا تُدار، بل تُحرَّر.
زمن ولادة فلسطين التي تعيد للإنسان معنى الإنسان، وللتاريخ اتجاهه، وللعالم معيار العدالة. فكما قال محمود درويش، “على هذه الأرض ما يستحق الحياة” – لأن الحياة هنا تُعاد تعريفها بوصفها حرية وكرامة، لا عيشا تحت الوصاية.
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center