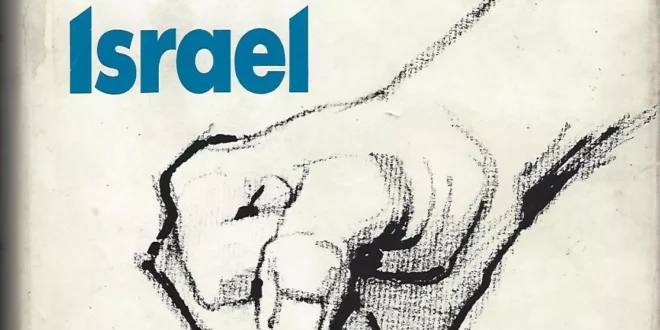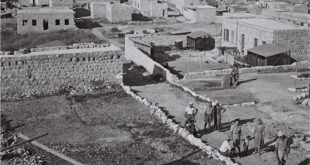صدر في إسرائيل العام 1969 كتاب تحت عنوان “לקחי מלחמה ותבוסה” [ليكاحي ميلخاما وتفوسا]، والذي يعني حرفياً (دروس الحرب والهزيمة). أما النسخة الإنكليزية منه، فقد نشرت في العام 1972 تحت عنوان”The Arab Attitude to Israel” [الموقف العربي من إسرائيل].
مؤلف الكتاب يهوشافاط هركابي (1921-1994) جنرال إسرائيلي بارز ترأس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) بين عامي 1955 و1959.، وكان أحد وجوه حزب العمل الحاكم آنذاك. وعلى الرغم من أن بعض آرائه وتحليلاته أثارت جدلاً داخل المؤسسة الإسرائيلية، لاسيما تحذيراته من استمرار الصراع (بين العرب وإسرائيل) دون حل جذري، إلا أن أطروحاته تحولت، في مرحلة ما، إلى مرجعية مهمة في الأوساط الأمنية والسياسية.
يعتبر هركابي من أهم مؤسسي الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية بعد قيام الدولة، حيث لعب دوراً محورياً في تشكيل السياسات العسكرية والأمنية والفكرية تجاه العرب، ولا تزال بصماته واضحةً في المشهد الأمني الإسرائيلي حتى اليوم، من خلال استراتيجيات طبّقها الكيان الصهيوني لاحقاً، وتحوّلت إلى جزء من “الترسانة الفكرية” التي تعتمدها إسرائيل في تعاملها مع الصراع العربي.
عمل يهوشافاط هركابي أستاذاً في الجامعة العبرية بعد مغادرته المؤسسة العسكرية، حيث قدَّم مساقات أكاديمية تركّز على تحليل جذور الصراع العربي الإسرائيلي، مع اهتمام خاص بدراسة الفكر العربي وسياساته تجاه إسرائيل. ولم يقتصر عمله على الجانب النظري، بل سعى إلى تفكيك العوامل السياسية والإيديولوجية التي شكَّلت الموقف العربي، مُحللاً ردود الفعل العربية على الهزائم العسكرية المتتالية، بدءً من حرب 1948 وحتى حرب 1967.
عمد هركابي إلى تقديم رؤيةٍ هجينة تجمع بين الحس الأمني (الاستخباراتي) والبراغماتية السياسية، داعياً إسرائيل إلى تبني استراتيجياتٍ تزاوج بين القوة العسكرية الحازمة والمناورة الدبلوماسية، عبر تسويات سياسية مشروطة تخدم مصالحها دون إغفال تعقيدات الصراع.
ورغم الأهمية الاستثنائية للكتاب في فهم الرؤية الإسرائيلية للصراع، إلا أنه لم يُترجم إلى العربية حتى اليوم (على حد علمي). وتكمن أسباب هذه الفجوة، باعتقادي، في عاملين رئيسيين:
-احتوائه تحليلات استخباراتية دقيقة تظهر ضعف الأداء العسكري العربي، مثل الفساد وسوء التخطيط، والتي تتعارض مع الرواية الرسمية العربية التي روَّجت لـ”مؤامرة خارجية” كسبب وحيد للهزيمة.
-سيطرة الأنظمة العربية على السردية الرسمية للحرب، حيث حرصت هذه الأنظمة -بعد هزيمة 1967- على احتكار تفسير (اقرأها أيضاً تأويل) الهزيمة، وتوجيهها لخدمة استقرارها الداخلي. وترجمة كتاب كهذا، سيكشف ثغرات داخلية، كانت ستُضعف هذه السردية الرسمية.
لذا، اقتصر تداول أفكار الكتاب على نطاقٍ ضيق في الأوساط الأكاديمية، من خلال مقتطفاتٍ أو إشارات عابرة في أبحاث نادرة. بل إن بعض هذه الدراسات تعاملت معه بوصفه “وثيقةً استخباراتية” أكثر من كونه عملاً أكاديمياً، مما عمَّق الفجوة بين التحليل العلمي والخطاب العام
يركز الكتاب على تشريح الخطاب العربي، ويتتبع كتابات المفكرين والسياسيين العرب المعاصرين لحقبته، محاولاً كشف الأسباب الجوهرية للهزيمة بعيداً عن السرديات الرسمية. فمن ناحية، يحلل المؤلف التوجهات الإيديولوجية التي هيمنت على الفكر العربي آنذاك (كالقومية والاشتراكية)، ومن ناحية أخرى، يرصد ردود الفعل العربية المتباينة على الهزائم العسكرية المتكررة.
لا هركابي بوصف هذه الظواهر فقط، بل يربط بين عوامل ثلاثة شكلت الاستجابة العربية: العامل الفكري، حيث يهيمن الخطاب الثوري الرافض للتفاوض. والعامل العقائدي، لجهة تأثير الشعارات القومية والدينية على صناعة القرار. وأخيراً، العامل السياسي، حيث تنقسم الأنظمة العربية بين محورَي “المقاومة” و”التطبيع”.
ينطلق الكتاب من فرضية “استشراقية عنصرية” مفادها أن فهم عقلية الهزيمة العربية (كثقافةٍ سياسية ومجتمعية) هو مفتاح تعامل إسرائيل مع جيرانها. ولتحقيق ذلك، يدعو إلى مسارين استراتيجيين، يتتبع الأول مسلكاً عسكرياً صارماً للحفاظ على التفوق الأمني الإسرائيلي كضمانة ضد أي تهديدات. وبالتوازي مع ذلك يأتي المسار الثاني، وهو من طبيعة سياسية مرنة ومنفتحة على تسويات مرحلية مشروطة تفرضها الوقائع الميدانية، دون التخلي عن الثوابت الإسرائيلية. فقد اتسم الخطاب الرسمي العربي بعد الهزيمة بفيض من الشعارات التعبوية مثل “الحرب طويلة الأمد” و”إعداد الجيل القادم للنصر”، والتي رأى هركابي أنها مجرد أغطية تخفي فجوات عميقة في بنية الأنظمة العربية. فكشف بتحليله للهزيمة، أن هذه السرديات لم تكن سوى محاولة لـتجنب الاعتراف بالأخطاء الداخلية التي قادت إلى النكبة، مثل الفساد وسوء التخطيط، والتي لو ظهرت للعلن فسوف تهدد شرعية هذه الأنظمة التي اتخذت من القضية الفلسطينية ذريعة لتمسكها بالسلطة.
فكيف إذن تعامل العرب مع هزائمهم أمام إسرائيل، ولماذا لم يتعلموا منها؟
يحاول هركابي الإجابة عن هذا السؤال -مفترضاً- أن الهزائم العسكرية التي لحقت بالعرب (خاصة في 1948 و1956 وكذلك 1967) لم تُنتج مراجعة فكرية أو سياسية أو حتى عسكرية جذرية، بل عكست نمط تعامل متكرر يتسم بالتهرب من المسؤولية باختلاق مبررات خارجية (مؤامرات استعمارية، خيانات داخلية). والتشبث بالشعارات كتعويض عن العجز عن مواجهة الأسباب الحقيقية (ضعف القيادة، غياب الاستراتيجية). والانزياح نحو التطرف، حيث غذت الهزائم الخطاب الراديكالي للتيارات القومية والدينية، دون دفعها نحو حلول واقعية. ويُبرز هركابي مفارقة خطيرة في هذا السياق، إذ كلما ازدادت الهزائم، ازدادت الأنظمة تمسكاً بخطاب العداء المطلق لإسرائيل، ليس بدافع القناعة، بل كـأداةٍ لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها الداخلية. وهكذا، تحول الصراع إلى حلقة مفرغة، هزيمة، فتصعيد، ثم هزيمة جديدة، فمزيد من التصعيد.
فهزيمة العرب، كما يصفها هركابي، كانت بمنزلة الوقود للصراع. ويخلص إلى أن التعامل العربي معها لم يُنتج حلولاً، بل حوَّلها إلى “أجندة مؤجلة مرتحلة”. وصارت تقدم للجمهور على أنها “مرحلة مؤقتة” في صراعٍ طويل، ما يسمح للأنظمة بالاستمرار في توظيف القضية لشرعنتها، وفي ذات الوقت، يُعقِّد أي احتمالٍ لمسار دبلوماسي واقعي للوصول إلى تسوية نهائية.
تحولت أفكار هركابي من أروقة الأكاديميا إلى ميدان تنفيذ السياسات الفعلية، فشكَّلت أطروحاته أسساً استراتيجية للسياسات الإسرائيلية تجاه العرب، لا سيما في الجانبين العسكري والأمني. فتحليلاته للعقلية العربية، التي رأى أنها لا تتعلم من الهزائم وتتمسك بالعناد، حوَّلها صناع القرار الإسرائيلي إلى دليل عمل إرشادي، سار على نهجه معظم رجال السياسة الإسرائيليين- على اختلاف مشاربهم وأطيافهم الفكرية، ولكن تجمعهم عقيدتهم الصهيونية- برفضهم التنازلات السريعة أو الانسحابات غير المشروطة والتشبث بضرورة ضمانات أمنية صارمة (كوجود قوات دولية أو حدود مُعزَّزة) مقابل أي تنازلٍ إقليمي. وتبني مقولة “حتى لو انسحبنا من جميع الأراضي المحتلة، فلن يعترف العرب بوجودنا”. كما طبق هؤلاء أفكار هركابي الخاصة بعقيدة الضربة الاستباقية وتطوير “الضربة الأولى” التي تجنّب إسرائيل مواجهة جيوش عربية متحالفة (كما حدث في حرب 1967). ومنع العرب من “استجماع قواهم” عبر حروب خاطفة تُدمّر بنيتهم العسكرية قبل اكتمالها.
ويرى هركابي أن على إسرائيل رفض “السلام السهل” واعتماد السلام المشروط بالقوة، القائم على فرض تسويات من موقع الضغط العسكري، الذي يعزز المكاسب الإسرائيلية، ( من هنا كان على إسرائيل فرض قبضتها العسكرية على المناطق الحيوية (كمرتفعات الجولان) كرهان لفرض الأمر الواقع. واستثمار نقاط الضعف العربية. عبر بناء جهاز استخباراتي ضخم ومتطور لرصد الانقسامات الداخلية العربية (الطائفية، السياسية، الاقتصادية)، وتوظيف المعلومات المتحصل عليها لتفكيك التضامن العربي، وخلق تحالفات ثنائية تُضعِف الجبهة المعارِضة.
ويندرج هذا في سياق “الهيمنة” كاستراتيجية وجودية، حيث تُصنع السياسة في إسرائيل ليست بوصفها ردود أفعالٍ على الأرض، بل بوصفها نتاج رؤية طويلة الأمد. فالإصرار على ربط أي تسوية بـ”إخضاع الخصم”، عبر مزيجٍ من القوة العسكرية والمناورة السياسية، لم يكرس الاحتلال فحسب، بل حوَّل الصراع إلى معادلة أحادية الجانب: إما القبول بالهيمنة الإسرائيلية، أو الاستمرار في مواجهة خاسرة، وبالتالي الخضوع والقبول بالأمر الواقع، وانعكس هذا في السلوك الاستراتيجي الإسرائيلي الذي اعتمد على الحروب الخاطفة التي تمنع العرب من التقاط أنفاسهم، و تطوير جهاز استخبارات قوي لتحليل نقاط الضعف العربية. وتعزيز الاستيطان، وتشديد العقوبات ضد الفلسطينيين، لأن العقلية الإسرائيلية التي تأثرت بهذه الدراسات ترى أن “القوة وحدها هي التي تجعل العرب يعترفون بالواقع”. وهو ما بات يعرف بالأدبيات الإسرائيلية منذ نهاية ستينيات القرن الماضي باستراتيجية “كيّ الوعي”، أي فرض واقع شديد القسوة على العرب ليدركوا أن المقاومة مكلفة جداً ( أفضل مثال على هذه الاستراتيجية ، تعامل السلطات الإسرائيلية الاستعمارية مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتشديد الحصار على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء من خلال الحصار الاقتصادي أو الحواجز العسكرية. وتجلَّى هذا المنهج عبر سياسات ميدانية واضحة مثل الحروب الخاطفة، يهدف منع العرب من “التقاط أنفاسهم” أو إعادة ترتيب اوراقهم كحرب 1967 التي دمَّرت الجيوش العربية قبل اكتمال استعداداتها، أو مبدأ الحروب “المنفردة” مثل حرب 1982 ضد المقاومة الفلسطينية في لبنان. ولن تنجح هذه المبادئ دون جهاز استخباراتي هجومي يحول نقاط الضعف العربية (كالانقسامات الداخلية) إلى أداةٍ لتفكيك التضامن العربي.
تحولت أفكار هركابي على أرض الواقع بالانتقال في سياسة “كيّ الوعي” إلى سياسات “العقاب الجماعي”، وأبرز أمثلته حصار قطاع غزة، وفرض شبكة من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان كآليةٍ لـ”خلق واقعٍ حياتي لا يُطاق”، وجعل تكلفة المقاومة أعلى من تحمُّل الاحتلال نفسه.
يقدم الكتاب رؤية استعلائية، اعتبرت أن العرب “لا يفهمون سوى لغة القوة”، وهو ما حوَّله صناع القرار الإسرائيلي إلى ذريعة لتبرير سياسات القمع الممنهج والاقتلاع الوطني لخلق معاناة مادية ونفسية متعمدة (كالحصار والتهجير) لإقناع الفلسطينيين باستحالة المقاومة، وترسيخ الاحتلال، وتحويل الصراع إلى معادلةٍ أحادية الجانب (“إما القبول بالهيمنة أو الموت”) بهدف إضعاف الفلسطينيين وقتل أي أملٍ في حلّ عادل.
يُمثِّل كتاب هركابي نموذجاً صارخاً للفكر الاستعماري، حيث يعيد إنتاج المنهجيات ذاتها التي استخدمتها القوى الاستعمارية التقليدية لدراسة المجتمعات الأصلية لاختراقها وإخضاعها. فتحليلاته، التي صبغتها خلفيته الاستخباراتية، هدفت إلى تبرير الاستمرار في سياسات الاحتلال، وتقديم صورة مشوَّهة للعقلية العربية، تحركها العواطف، والعناد على الحلول. وهو بهذا ينتقل من التقليد الاستعماري القديم لـ “همجية السكان الأصليين” إلى “العناد العربي” كتعبير عن السير على خطى الرؤية الاستعلائية للاستعمار الأوروبي.
ومثلما ادعى اللورد كرومر أن المصريين “غير مؤهلين للحكم الذاتي”، ليبرر استمرار الهيمنة البريطانية. ومثلما روّج الجنرال بيجو في الجزائر:-مؤسس الاستيطان العسكري الفرنسي- لفكرة أن العرب “لا يفهمون سوى لغة القوة”. ها هو يصور هركابي العرب في فلسطين كشعب “لا يتعلم من الهزائم”. وتتشارك هذه الثلاثية الاستعمارية في جوهر واحد تتمثل في نفي القدرة عن “الآخر” لتبرير احتلاله.
لم تكن أدوات هركابي الفكرية منفصلةً عن تاريخ الاستعمار الاستيطاني العالمي، بل هي حلقة في سلسلةٍ طويلة، فقد استخدم المستعمِرون الأوروبيون في أمريكا الشمالية وأستراليا وكندا، علوم الأنثروبولوجيا لدراسة القبائل الأصلية لتفكيك تحالفاتها وترويج أسطورة “همجيتها المتأصلة”. كما أجريت في جنوب أفريقيا العنصرية “دراسات حول البانتو” لتبرير نظام الفصل العنصري وسياسات “المعازل”، بزعم أن السود “غير قادرين على حكم أنفسهم”.
أما في فلسطين، فيحول هركابي الاستخبارات العسكرية إلى أداة تفكيك أكاديمية ممنهجة لتصوير العرب كشعب “يعجز عن استخلاص الدروس”، مما يشرعن سياسات التهجير والحصار، وتحويل الإنسان الفلسطيني والعربي إلى “كائن استعماري” يُدرَس ليُهزَم.
ويكرر هركابي مقولة أن “اللين لا ينفع مع العرب، بل يجب تعزيز السيطرة العسكرية والنفسية لـ “تطويعهم” في إعادة لإنتاج “أسطورة تفوق العرق الأبيض” التي تفترض “استحالة التعايش بين المستوطنين “الأوروبيين” والسكان الأصليين”.
لم يبتكر هركابي منهجاً جديداً، بل يمكن رؤية إرث الاستعمار القديم في عباءة الصهيوني، من خلال استعادة أدوات استعمارية مُجربة لـ”إدارة السكان الأصليين”. وكما أنتج البريطانيون بعد قمع ثورة 1857 في الهند دراسات تركز على “فشل الهنود التنظيمي” لزرع اليأس في صفوفهم والتلاعب بذاكرة الهزيمة، حاول هركابي تعميق إحساس العرب بـ”العجز” عبر ترديد مقولة “الهزيمة المستمرة”، فقدَّم الاحتلال الإسرائيلي كـ”ضرورة تاريخية” لدفع العرب نحو “القبول بالواقع” واعتبار المقاومة مغامرة غير عقلانية وعلى الضحية الاقتناع بالاستسلام وعدم الجدوى من المقاومة. وهو تصور لا يبتعد عن ترديد الفرنسيين لعبارة “الفتح الرحيم” في الجزائر.
ومن الهند إلى الجزائر إلى فلسطين نرى ذات الأدوات وذات الأكاذيب، والخطير في أطروحات هركابي أنها ليست مجرد تنظير، بل هي “كتالوغ” استعماري حديث، يجسد استمرارية مروعة بين الماضي والحاضر، من خلال زعزعة ثقة الفلسطينيين والعرب بذواتهم وترسيخ دراسات “الفشل” والترويج لخرافة “الوصاية الحضارية” و”الفيلا داخل الغابة” و”حصن الحضارة المتقدم في وجه الهمجية”.
إن ما يفعله هركابي-باختصار- تحويل هزيمة العرب إلى “سُنة تاريخية” لا مفر منها. وما كتاباته سوى فصل جديد من سردية التفوق الأبيض يعاد تدويرها، بحيث تُستبدل “المهمة الحضارية” الأوروبية التي ترسخت منذ القرن السادس عشر في عقول وسلوك الاستعماريين الأوروبيين، بـ”الضرورة الأمنية” الإسرائيلية. فادعاء أن العرب “لا يتعلمون من الهزائم” لا ينطوي على أي سمة موضوعية ضمن أي تحليل من أي نوع، بل هو في الحقيقة والواقع، أداة لترسيخ الاحتلال، تماماً كما كانت دراسات البانتو في جنوب أفريقيا ذريعةً لـ “تجميد التحرر” إلى الأبد.
ولا تختلف فكرة “عجز العرب عن التعلم من الهزائم” عن الخطاب الاستعماري الكلاسيكي الذي كان يَصِف الشعوب المُستَعمَرة بـ”البدائية” أو “عدم النضج”، ليُبرِّر البقاء الأبدي للمستعمر. فالمستعمِر “يخلق صورة المُستعمَر كي يبرر وجوده”.، وبتحول الحركة الصهيونية من مشروع قومي إلى دولة استعمار استيطاني فقد ورثت المنطق الاستعماري هذا، فحوَّلت “عجز العرب” إلى ذريعة لسياسات عسكرية غير مهادنة مثل الضربات الاستباقية (كما في تدمير المفاعل النووي العراقي في العام 1981)، والرفض الممنهج للتنازلات (الإصرار على رفض العودة لحدود 1967 حتى في مفاوضات السلام). وليس أقلها التوسع الاستيطاني اليومي كأداة لـ”خلق وقائع لا رجعة عنها”.
لم يكن هركابي مجرد “باحث”، بل كان جندياً في حرب المعرفة الاستعمارية، التي تعتمد على تفكيك الذاكرة الجمعية، وشيطنة المقاومة وتشويه سرديتها وتحويل الهزيمة إلى قدر محتوم، فـ “هم” “لا يتعلمون من أخطائهم” وعليهم القبول بالتفوق الإسرائيلي لتحسين وضعهم.
ولا تكمن أهمية الكتاب في كشفه عن “الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية”، بل في تعريته لآلية أذرع العمل الاستعماري الاستيطاني: الجيش لتحطيم الجسد. والأكاديميا لتحطيم السردية والإعلام لتحطيم الصورة. فالدرس الأهم هنا ليس كيف هُزم العرب عسكرياً، بل كيف جرى تحويل هزيمتهم إلى “حقيقة مطلقة” في الوعي الجمعي العالمي، عبر أدوات استعمارية عمرها قرون… عادت اليوم بزي صهيوني إسرائيلي حديث.
وللحق، يُقدم هركابي قراءة ذكية، وإن كانت شريرة، للعقلية العربية، معتبراً أن الميل إلى إلقاء اللوم الداخلي بعد الهزائم يُعدّ “الثغرة الذهبية” التي يمكن اختراق العرب عبرها. فبدلاً من تحميل المسؤولية للاحتلال أو الخلل الاستراتيجي، يتحوّل النقاش، بزعمه، إلى معركة جانبية بين الأنظمة والقوى العربية حول “مَن الخائن؟”. وهذا ما حوّلته إسرائيل إلى استراتيجية منهجية عبر تأجيج الصراعات العربية-العربية عن طريق التلاعب، على سبيل المثال، بالخلاف بين عبد الناصر والأنظمة الملكية في الستينيات، من خلال تسريب معلومات تُظهر دعم الأخيرة لإسرائيل. كما عمدت إلى تحييد الجبهات عبر اتفاقيات سلام منفردة بدءً من كامب ديفيد، ثم اتفاقية أوسلو ووادي عربة وأخيراً السلام الإبراهيمي مما نزع عن الفلسطينيين درعهم العربي.
واستغلت إسرائيل نظرية المؤامرة على أكمل وجه في إعادة كتابة السردية العربية، فلم تكتف باستغلال الانقسامات القائمة، بل عملت على تصنيعها عبر تضخيم الخلافات العابرة وتحويلها إلى أزمات وجودية (مثل نشر تقارير استخباراتية مزيفة)، وترويج سردية “الشريك المعتدل” مقابل “المتطرف” وتحويل النظام العربي إلى “معسكرين” لا يثقان ببعضهما البعض. واستخدام السلام الاقتصادي كأداة لتحييد موقف بعض الدول (خاصة دول الطوق) من القضية الفلسطينية. وهي أساليب عمل قريبة من طرح “الفوضى الخلاقة” الذي برز بشدة أثناء وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق. ولكن إسرائيل تعاملت معه وفقاً لإرشادات هركابي بثوب استعماري تقليدي من خلال سياسات “فرّق تسد” وتحويل الصراع إلى حرب داخلية عربية. وبالتالي استبدال العدو الإسرائيلي بعدو “عربي”. وتوظيف السلام كسلاح لإخضاع الشعوب.
لم تكن دراسات هركابي وأمثاله مجرد أوراق بحثية، بل كانت أدوات تفكيكٍ ممنهج تخدم هدفاً مزدوجاً. أولاً، ترسيخ الصورة النمطية للعرب في الغرب: عبر تصويرهم كشعوب “غير عقلانية” و”رافضة للسلام”، وهو ما عزَّز السردية الإسرائيلية بأن الصراع ليس ناتجاً عن احتلالٍ أو استيطان، بل عن “عنادٍ عربيٍ متأصل” وثانياً، تلميع صورة إسرائيل كـ”ضحية محاصرة”: و “واحة ديمقراطية محاطة بجيران يرفضون وجودها”، فحولت الاحتلال إلى “دفاع عن النفس” وقدمت نفسها كـ”دولة غربية”، ووجودها ضرورة حضارية في مواجهة “البربرية الشرقية”، وهي ذات الصورة التي روَّجها الاستعمار الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
لعل إسرائيل نجحت –جزئياً– في فرض سياسات استيطانية توسعية، مستفيدةً من انقسامات النظام العربي وغياب إستراتيجيةٍ موحدة. لكن هذا “النجاح” لم يُترجم إلى هيمنة مطلقة، إذ ظلّت الشعوب العربية –رغم كل محاولات كسر إرادتها– تُنتج أشكالاً متجددة من المقاومة والرفض، سواء عبر انتفاضاتٍ شعبية، أو مقاومة مسلحة، أو حتى حملات مقاطعة دولية (BDS) تُعيد تعريف الصراع بعيداً عن الأدوات التقليدية. وتعرف المشروع الاستعماري كما هو على أرض الواقع.
لم تكن نصيحة هركابي –بتركيز إسرائيل على المفاوضات– تنطلق من إيمان بالسلام، بل من قراءة براغماتية للمشهد، وتحويل المكاسب العسكرية إلى مكاسب سياسية. واستغلال الانهيار النفسي العربي عبر فرض شروط مُجحفة تحت ذريعة أن العرب “لا يملكون خياراً غير القبول”. ومن ثم إعادة تعريف الصراع من نزاع وجودي بين محتل وشعب مُهجر، إلى “خلافات حدودية” قابلة للحلّ بمنطق التبادل التجاري!
وحين يصاب المستعمِر بمرض “الوهم” ينتقل إلى خدعة “الانتصار عبر التفاوض”. وهذا ما يؤكده ما جاء على لسان هركابي نفسه في تقريره للكنيست عقب حرب 1973: “يجب أن تكون هذه آخر حرب بيننا وبين العرب… لقد قاتلنا العرب في عدة حروب وهزمناهم عسكرياً لكن في إثر كل حرب يتولد مشهد سياسي أكثر تعقيداً وتزداد مشكلتنا مع العرب تعقيداً. لن تمنح الحرب ضد العرب الأمن لإسرائيل، بل كل حرب تلد حرباً أخرى، وأن أفضل طريقة تكمن في التركيز على التسوية السياسية التي يمكن من خلالها أن نحقق الانتصار النهائي على العرب ومن الممكن أن نأخذ منهم على طاولة المفاوضات أكثر مما نأخذه منهم في الحرب، فطبيعة العقل العربي والشخصية العربية تؤكد لنا ذلك. إن العربي عنيد في الحروب والمواجهات، ولكنه مَلُول في الحوار والمفاوضة ومن الممكن – ولأنَّه قصير النَفَس وفاقد للرؤية السياسية ومُهشم من الداخل نتيجة الهزائم العسكرية المتكررة- استخلاص مكاسب سياسية عديدة منه على طاولة المفاوضات”.
لا يُمثّل كتاب هركابي –في جوهره– محاولة لفهم العرب، بل هو مرآة عاكسة لرعب المستعمِر الدفين من الآخر “الأصلي” الذي يرفض الاختفاء. فتحليلاته التي تزعم “عجز العرب عن التعلّم” ليست سوى تعبير عن خوف إسرائيل من نهوض وعي عربي يُعيد تركيب المعادلة، ويكشف زيف الرواية الاستعمارية التي تختزل الصراع في “رفض عربي للتعايش”.
تشكل دراسة هركابي جزءً من الأدبيات الإسرائيلية التي حاولت فهم العقلية العربية في الصراع، لكنها عكست رؤية إسرائيلية منحازة، حيث لم تأخذ في الاعتبار العوامل العميقة التي أثرت على الموقف العربي، مثل الاستعمار وتدخل القوى الكبرى. وهكذا، حين يكون “الفشل الاستعماري” هو الدليل على قوة الشعوب، يكون الدرس الأهم الذي تقدمه تجربة الصراع ليس “نجاح” إسرائيل في التوسع، بل فشلها في قتل الأمل. فالشعوب التي تمتلك إرادة البقاء تظل قادرة على اختراق كل محاولات “التطويع” الاستعماري، وإثبات أن الحقوق لا تُورَث بالهزيمة، ولا تُنسى بالتقادم.
ملحق
من وحي أفكار هركابي، ظهر كتاب يمثل مزيجاً مريباً بين الأنثروبولوجيا والاستشراق الكلاسيكي، لمؤلفه رافائيل باتاي “العقل العربيThe Arab Mind ” (1973) كـ “محاولة” إثنولوجية/نفسية/ ثقافي لتحليل الشخصية العربية بوصفها كياناً عاماً متجانساً، وفقاً للخلفية الإسلامية والعادات الاجتماعية، بغض النظر عن التنوع الجغرافي أو التاريخي.
يقوم باتاي بـ “صنع” العربي النمطي عبر استخدام الأنثروبولوجيا الثقافية بدءً من افتراض استعلائي يرى أن العقل العربي -بحكم الإسلام والتقاليد القبلية- ينتج شخصية ذات سمات مرضية يقع في قلبها مركزية الشرف والحساسية المفرطة تجاه “العار” والكرامة في تشكيل الشخصية، ودور السلطة الأبوية والتراتبية الصارمة في البنية العائلية، وأهمية الكرامة والضيافة في الحياة اليومية، وغياب التسامح النقدي، النزوع إلى التعميم، والخلط بين الذات والعائلة والقبيلة. والميل الثقافي إلى الثأر والحلول العنيفة للنزاعات. فضلاً عن مركزية الجنس في الثقافة العربية، و “الكبت الجنسي” و”الهاجس الجنسي” لدى الرجل العربي وتأثيره على السلوك العام، والتأثير الحاسم للنصوص الدينية والغلبة العاطفية على العقلانية، وبالتالي على السلوك والتفكير…(” فالبلاغة بالنسبة للعربي هي إنجاز يشبه تحقيق الرجولة (أو البلوغ الذكوري). من نفس الجذر اللفظي يُشتق الاسم ‘مبالغة’، الذي يعني المبالغة اللفظية أو الغلو. في العقل العربي، ترتبط البلاغة بالمبالغة، التي لا يُقصد بها أن تُؤخذ حرفيًا ولكن… تخدم غرض التأثير.” [ انظر هنا https://dougvos.com/the-arab-mind/?utm_source=chatgpt.com] ).
ويرى باتاي أن هذه “الصفات” ليست مجرد نتاج للظروف الاجتماعية أو السياسية، بل هي متجذرة في لاوعي ثقافي جمعي، ينتقل من جيل إلى آخر داخل المجتمعات العربية، وكأنها مكوّن بنيوي في الشخصية العربية. ولهذا السبب، يميل إلى إطلاق تعميمات واسعة تُختزل فيها الشعوب العربية ضمن “هوية جوهرانية Essentialism ” ثابتة لا تتغير، أي افتراض وجود سمات فطرية ودائمة تميز مجموعة بشرية عن غيرها، بغض النظر عن التاريخ أو السياق أو التنوع الداخلي. علماً أنه يستمد مصادره طروحاته واستنتاجاته المعرفية من مراجع تراثية قديمة، وروايات استشراقية، وسرديات غربية عن العرب، مع غياب شبه تام لأصوات عربية معاصرة أو دراسات ميدانية موثوقة. وهذا ما يجعل الكتاب يميل إلى التعميم الذي ينقصه البرهان على صحته، وإلى اختزال شعوب وثقافات متنوّعة ضمن قالب نمطي واحد مهين، يُستخدم لتبرير التفوق الغربي، ويعكس تحويل الخطاب الثقافي إلى سلاح، ويُفرغ الأفراد من خصوصيتهم وتنوعهم، ليجعل منهم “نماذج” قابلة للترويض والسيطرة، على طريقة المستشرقين العنصريين.
وهو بهذا الوصف يعد مثالًا على تسييس المعرفة الأنثروبولوجية لخدمة أهداف استعمارية أو استعمارية جديدة. مثلما اعتبره البعض أداة عنصرية دعمت سياسات الاحتلال الأميركي في العراق لاحقاً، حيث تشير تقارير إلى استخدامه من قِبل الاستخبارات والجيش الأميركي لفهم كيفية “إخضاع” المجتمع العربي. (يقول “باتاي” في هذا الخصوص “لقد كان من ملاحظتي أن النساء هن بالفعل عوامل حاسمة للتغيير في العالم العربي. لقد كنت دائماً معجباً بتفكيرهن الأكثر تقدماً وتنويراً بشأن القضايا التي تؤثر على المجتمع العربي. كان هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للنساء العراقيات اللواتي عملت معهن في بغداد من حزيران 2003 إلى كانون الثاني 2004. هنّ أكثر عقلانية وواقعية من الرجال، وهنّ المفتاح للتغيير الثقافي والسياسي في عالمهن.”)
لكن أهم منبع لأفكار “باتاي” تأتي من أطروحة يهوشافاط هركابي -حتى أنه استمد عنوان كتابه من عنوان كتاب هركابي نفسه- في سياق عمل هركابي على تحليل البنية الذهنية والثقافية لدى “العدو” ، وأن العرب تحكمهم “نفسية جماعية” مشحونة بالعجز، الفخر الزائد، الحساسية للعار، والميول إلى العنف، وهي خصائص ادّعى أنها تمنع التسوية السلمية وتغذي الصراع. لكن “باتاي” تخطى ذلك نحو مطارح أكثر تجريداً وثباتاً حين أن “العقل العربي” ليس مجرد نتاج ظروف سياسية أو اجتماعية معينة، بل منظومة ثقافية شبه مغلقة ذات ملامح خاصة فيما اعتبره جذوراً ثقافية ونفسية دافعة، ينبغي فهمها حتى يمكن التعامل مع العرب سياسياً وعسكرياً.
…….
تعتمد هذه المادة على الكتاب وعلى المصادر الرئيسة التالية:
1.Brute force and impudence. https://electronicintifada.net/content/brute-force-and-impudence/31756?utm_source=chatgpt.com
2.Rhetoric and the Arab Mind. https://www.commentary.org/articles/robert-alter-2/rhetoric-and-the-arab-mind/?utm_source=chatgpt.com
3.The Development of Arab Anti-Semitism https://jcpa.org/article/the-development-of-arab-anti-semitism/
4.Arab Strategies and Israel’s Response, by Yehoshafat Harkabi https://www.commentary.org/articles/edward-grossman/arab-strategies-and-israels-response-by-yehoshafat-harkabi/
5.Yehoshafat Harkabi and the Arab Israeli Conflict https://dl.tufts.edu/concern/pdfs/cr56nb47g
6.Yehoshafat Harkabi: Choosing between Bad and Worse https://www.jstor.org/stable/2536788
7.Israel’s Fateful Decisions Yehoshafat Harkabi https://www.jstor.org/stable/164141
8.The Iron Wall Revisited https://www.palestine-studies.org/en/node/42543
- 9. Nasser’s Antisemitic War Against Israel https://fathomjournal.org/1967-nassers-antisemitic-war-against-israel/
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center