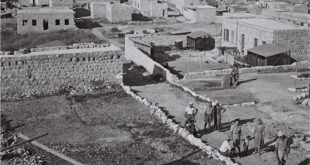“لا تعتادوا المشهد” جملةٌ استمر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتناقلها منذ الأسابيع الأولى للعدوان على قطاع غزة، خشيةً من إطالة أمده واعتياد الناس على أخبار ومشاهد الإبادة، وهو ما يتناوله هذا المقال؛ أي الصورة المأساوية القادمة من غزة، باعتبارها محفزًا للتأثير والتحرك من أجل التغيير من ناحية، ومن ناحية أخرى، قد تصبح هذه الصورة مشهدًا معتادًا مع تكرار نشرها لفترة زمنية طويلة، في سياق حالة عامة من الشعور بالإحباط والعجز.
ظلّ العدوان على غزة، وما تدفّق عنه من مواد بصرية ذات محتوى صادم، حدثًا مركزيًا يستقطب اهتمامًا واسعًا، على المستويات الإعلامية والدولية والشعبية. وتمتلك المواد البصرية، من صورٍ ومقاطع فيديو، قدرةً على إحداث تأثير يتعدّى عملية توثيق الحدث ونقل المعلومات. وأكثرها قسوةً تلك التي تصوّر وقائع صادمة؛ كلحظات القصف المصحوبة بالصراخ والهلع وسقوط الضحايا، والأشلاء البشرية، وبشر يحترقون، وجثث متفحّمة، وأخرى تنهشها الكلاب، ومشاهد لجثث كثيرة ملفوفة بالأكفان، وجنائز جماعية، وأكياس الأشلاء، ومعتقلين عراة تُنتهك كرامتهم بفظاعة.
من خلال قدرتها الكبيرة على استثارة المشاعر الإنسانية، كالغضب والحزن والألم، غالبًا ما تثير هذه المشاهد، التي تعكس أشكالًا من المعاناة القاسية، ردود فعل فورية وقوية لدى مشاهديها، تُترجم إلى حراك تضامنيّ، يتمثل في أشكال من الاحتجاج، كالتظاهرات والمسيرات، والحملات التضامنية، وجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية، وتفعيل حملات المقاطعة. فلا شك في أن المواد البصرية والإعلامية، لعبت دورًا رئيسًا في انتشار وتعزيز حركة تضامن عالمية مع غزة، والقضية الفلسطينية بعامة.
التحفيز اليومي للتضامن
تصبح المشاركة النشطة في نشر المواد البصرية والأخبار من غزة، على مواقع التواصل الاجتماعي، شكلًا من الاحتجاج وجزءًا من الحراك التضامني والمناصر، عبر الاستمرار في تفعيل دائرة التأثير والتأثر؛ أي التعزيز اليومي لحالة التضامن وتجديدها وتحفيزها، عبر نشر الأخبار والمواد البصرية، الذي هو بذاته، أي عملية النشر، جزء من هذا الحراك التضامنيّ.
وعبر هذا التداول اليومي والتراكميّ، طُرحت وانتشرت السردية الفلسطينية برمتها، نتيجة حاجة الشعوب إلى فهم السياق التاريخي (منذ النكبة) والجغرافي (فلسطين التاريخية) الذي أدى إلى أحداث السابع من أكتوبر وما بعدها. فلم يقتصر الحراك الشعبي على التضامن والتظاهر وتقديم المساعدات، أو الاكتفاء بالدعوة إلى وقف الإبادة، بل تجاوز ذلك إلى المطالبة بتغيير سياسي جذري لصالح الشعب الفلسطيني، وتبنّى، هذا الحراك، الحقوق الفلسطينية المتمثلة في الخلاص من الاستعمار.
لقد أحدثت حركة التضامن الواسعة تأثيرًا دوليًا أيضًا، عبر اتخاذ العديد من الحكومات والجهات والمنظمات الدولية مواقف داعمة للشعب الفلسطيني، وضد الاحتلال وحربه الإبادية على غزة. فاتجهت بعض الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل نتيجة لجرائمها في غزة، كإغلاق سفاراتها في بعض البلدان، ومحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت.
تأثيرات متضاربة
وعلى الرغم من قدرة المواد البصرية على تفعيل حركة تضامن شعبية ودولية واسعة، إلا أنه تُطرح هنا أسئلة جادّة وهامة حول فعالية استخدام الصور والفيديوهات ذات المحتوى الصادم، على المدى الطويل، في تحريك الرأي العام العالمي والتأثير على السياسات الدولية. والإجابة على ذلك ليست بسيطة، بل ترتبط بشبكة من العوامل المعقّدة والمتداخلة، السياسية والثقافية والنفسية والاجتماعية والإعلامية.
ذلك أنّ تأثير الصور ومقاطع الفيديو، التي توثّق أحداثًا قاسية، معقّد ومتعدّد الأبعاد، بل ومتضارب في انعكاساته؛ فعلى الرغم من أنها تولّد تعاطفًا وحراكًا شعبيًا متزايدًا، إلا أنها أيضًا تثير تساؤلات حول مبادئ وكيفيّات وأدوات نقل المعاناة، بما يساهم في تحقيق نتائج فعّالة لوقفها أو تقليلها ما أمكن.
وفي هذا السياق، تتضارب وجهات النظر حول مدى تأثير المواد البصرية المأساوية؛ فعلى الرغم من أنها مؤثرة فعلًا، إلا أن هناك من يرى أن الاستخدام المفرط للمواد البصرية، ذات المحتوى الصادم، قد يؤدي إلى حدوث حالة من التشبّع بين الجمهور، ما يقلّل بدوره من مستوى التعاطف على المدى الطويل. كما يعتبر آخرون أنها قد تتحول إلى مادة للاستغلال، إضافة إلى أن نشرها قد يعتبر انتهاكًا لإنسانية الضحايا، كصور جثث الشهداء في وضع قاسٍ، والأشلاء، والمعتقلين العراة. ويرى هؤلاء، أن عملية النشر يجب أن تتم بأسلوب يحترم إنسانية الضحايا، ويضمن عدم استغلال آلامهم لتحقيق أهداف سياسية أو إعلامية أو غيرها.
تعاطف مؤقّت وتشبّع إعلامي
على الرغم من أن هذه المشاهد تثير التعاطف، خاصةً عندما يتزامن نشرها مع توقيت الحدث، لا بعده بفترة، إلا أن هذا التعاطف غالبًا ما يكون مؤقّتًا ومحدودًا، وقد يتضاءل بعد فترة، مستبدَلًا بأخبار أخرى أو بأولويات مختلفة، وهذا حاصل فعلًا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تتميز بما يُعرف بـ “التريند”، أي الموضوع الساخن الذي ينتشر بسرعة ويصبح محط اهتمام الكثيرين.
كما يعاني الناس اليوم من تشبّع إعلامي كبير؛ فهم يتعرضون إلى فيض من الأخبار والصور المروّعة من جميع أنحاء العالم، ما يؤدّي إلى ما يُعرف بـ “إرهاق التعاطف”. لذا، من الممكن أن يصبح الناس أقل حساسية للمشاهد المروّعة مع كثرة تكرارها على مدى زمني طويل. يضاف إلى ما سبق، مسألة التحيّز الإعلامي، حيث تؤثّر الطريقة التي تُقدّم بها المشاهد القاسية على مسار تأثيرها. فقد تستخدمها بعض الجهات ووسائل الإعلام لتحقيق أهداف سياسية معيّنة، أو تعزيز أفكار محددة، مغيِّرةً من سياقها أو مبالِغةً في بعض الجوانب. هذا يمكن أن يؤدّي إلى تشكيك في مصداقية هذه المشاهد، أو حتى رفضها من قبل بعض الأطراف.
أيضًا، يؤثر الاختلاف في وجهات النظر، وتعدّد الانتماءات السياسية والثقافية، على طريقة استقبال هذه المشاهد؛ فبينما يرى كثيرون أنّها دليل على جرائم إبادة، يُفسّرها آخرون من خلال سياق مختلف يُبرّر الأفعال، على سبيل المثال، تستخدم وسائل إعلام الاحتلال، وبعض المعارضين لحركة حماس من مختلف البلدان، هذه المشاهد، لتعزيز الفكرة التي تصف فصائل المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، وتحمّلها مسؤولية الدمار والإبادة في غزة.
إرهاق التعاطف
يؤدّي تكرار المشاهد المروّعة في الحروب، والتشبّع الإعلامي، إلى ما يُعرف بـ “إرهاق التعاطف” Compassion Fatigue، وهو ردّ فعل نفسي يقوم به الأفراد المعرّضون بشكل متكرّر إلى معلومات وصور وفيديوهات حول الحروب والمعاناة، والعنف بمختلف أشكاله، يُترجم إلى حالة من الإرهاق العاطفي والجسدي، تتسبب في انخفاض مستوى التعاطف مع ضحايا الحدث المأساوي، مع تكرار التعرّض لأخباره.
يؤدّي إرهاق التعاطف بدوره، وما يتبعه من انخفاض في مستوى التضامن، إلى ما يبدو كأنه شكل من الاعتياد أو اللامبالاة، وفي الحقيقة هو ليس اعتيادًا أو لامبالاة، إذ لا يمكن أن تكون مشاهد جرائم الإبادة والدمار أمرًا عاديًا، وإنما هو أقرب إلى محاولة انفصال عن الحدث أو تجنّبه.
يستخدم الدماغ آليّات دفاعية للتعامل مع المعلومات المروّعة، مثل: التجنّب، أو التقليل من أهمية الأحداث، أو التنكّر للمأساة، أو تبنّي وجهات نظر تلوم الضحية كتبرير غير مباشر للجرائم. تُفسَّر ردود الفعل هذه على اختلافها، من الجانب النفسيّ، على أنها اتجاهات لحماية النفس من الصدمة عبر الانفصال عن الواقع المأساوي. غير أنها تؤدي بلا شك إلى انخفاض مستوى التعاطف.
يضاف إلى ذلك، طبيعة وسائل الإعلام، التي تركز غالبًا على الأخبار السلبية والأحداث المروّعة، ما يُعزّز شعور الناس باليأس واللامبالاة. كما تؤثّر المسافة الجغرافية والثقافية، بين المشاهد والضحايا، على مستوى التعاطف. يميل الناس، بشكل عام، إلى التعاطف أكثر مع الضحايا الأقرب إليهم ثقافيًا وجغرافيًا. غير أنه، وخلال العدوان على غزة، ظهرت أشكال من التضامن والتعاطف من قبل مختلف الشعوب والثقافات. ومع ذلك، يبقى للقرب الجغرافي والثقافي أثره بلا شك.
الاكتئاب – العزلة – السلبية
عند انخفاض مستوى التضامن لدى الأفراد مع ضحايا الحرب، والناتج عن التشبّع الإعلامي وإرهاق التعاطف، تصبح الأخبار حول الحرب مجرد سلاسل من الأرقام والحقائق، إذ تقلّ الرغبة لدى الأفراد في التدخّل أو المساهمة في جهود الإغاثة، ما يقلل بدوره من حجم التدخل الإنساني لوقف المأساة، ويُعيق جهود المناصرة والدعم. على المدى البعيد، قد يؤدّي تكرار التعرّض إلى المشاهد القاسية، إلى تعزيز اتجاهات مقلقة على المستوى الإنساني، وهي تبرير العنف والظلم، إذ قد يصبح الناس أقل حساسية لانتهاكات حقوق الإنسان.
مع استمرار معاناة الضحايا والتشبّع الإعلامي بأخبارهم، يبدأ الأفراد بالشعور بالعجز، لعدم قدرتهم على التدخل ووقف الإبادة، ما يؤدّي إلى اللجوء إلى العزلة النفسية والاجتماعية، والإصابة باضطرابات نفسية كالاكتئاب والقلق. كما ينتج عن فيض المشاهد المحزنة والقاسية والصادمة حالة من السلبية أو اللامبالاة، حيث يبدأ الأفراد في التفكير بأن الأوضاع لن تتغير، ما يفضي إلى الشعور بعدم الرغبة في التحرك من أجل التغيير.
ولتجنّب هذه الانعكاسات للتشبّع الإعلامي وإرهاق التعاطف، يرى المختصون أنه من المهم التوازن في استهلاك الأخبار، وتجنّب التعرّض المفرط والمبالَغ فيه إلى الأخبار المؤلمة والمشاهد القاسية، والتوجه بدلًا من ذلك، إلى القيام، ما أمكن، بفعل تضامنيّ إيجابي تجاه المأساة. ولمّا كان التعاطف واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا، فإنه من الضروري الحفاظ على التوازن النفسي من أجل القدرة على العطاء والاستمرار في التضامن ومدّ يد العون إلى الضحايا، والحفاظ كذلك على التوازن العاطفي، بعدم السماح للمشاعر بالسيطرة، خاصة مشاعر الغضب والألم والإحباط.
يرى العديد من الناشطين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان أن الاعتياد على رؤية المشاهد الصادمة يشكّل خطرًا حقيقيًا على القضايا الإنسانية؛ خاصة عندما تصبح يومية ومن بلدان عدة، وأنه من الضروري تجديد التعاطف مع المتأثّرين بالمأساة. على العكس من ذلك، يرى بعض الأشخاص أن الاعتياد على مثل هذه المشاهد يمكن أن يهيّئ الأفراد للتعامل مع الأزمات بشكل أكثر فعالية، ما يجعلهم أقل عرضة للصدمات النفسية.
رواية المأساة
يتطلب نقل المأساة الإنسانية في غزة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الصور والفيديوهات القاسية، اتباع استراتيجيات إعلامية أكثر تنوعًا وتأثيرًا، وتركّز على إبراز جوانب مختلفة من المعاناة بطرق أكثر فعالية دون التسبب في “إرهاق التعاطف”. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: التركيز على القصص الإنسانية، حيث يمكن تسليط الضوء على قصص شخصية، للجرحى، وذوي الشهداء، والنازحين، من الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، والتركيز على الأبعاد الإنسانية في تجاربهم وحكاياتهم مع المعاناة.
ويبقى السرد القصصي وسيلة قوية لنقل المشاعر والمعاني العميقة للحدث المأساوي، بدون الحاجة إلى تعزيزه بمشاهد قاسية، كما أنه يجعل الجمهور يشعر بارتباط وجداني وإنسانيّ أكبر مع الضحايا موضوع القصة. وبالمقابل، لا بد من تسليط الضوء على قصص الأمل والصمود والمبادرات الإيجابية في غزة، والتي تُظهر إرادة الغزيّين وحبّهم للحياة وقدرتهم على مواجهة التحدّيات القاسية التي فرضها واقع الحرب.
أيضًا، تعدّ الرسوم البيانية والمعلومات التوضيحية أدوات فعالة لتوضيح حجم المعاناة، وتساهم، عبر مخرجاتها البصرية اللافتة للانتباه، في شرح الأوضاع المعقّدة للحرب. يمكن استخدام هذه الأدوات لعرض الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمأساة، كأعداد الشهداء، والجرحى، والمفقودين، والنازحين، والمرضى، وحجم الدمار، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالأوضاع الصحية والغذائية والبيئية والنفسية وغيرها.
وتؤثر هذه الأرقام بشكل فعّال على الرأي العام. كما يمكن مقارنة الأوضاع في غزة مع المعايير الدولية في مجالات مختلفة، مثل الصحة، والتربية، والاقتصاد، لإظهار مدى المعاناة والحرمان.
إضافة إلى ما سبق، من المهم التركيز على الانعكاسات الطويلة الأمد للحرب والحصار، كالتأثيرات النفسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. ومن الأدوات المهمة لنقل المأساة: مقاطع الفيديو التي توثّق الظروف المعيشية للنازحين، والمصابين والمرضى، والمعزّزة بشهاداتهم. ويمكن الاستعانة، في هذه المقاطع، بالرسوم التوضيحية لنقل المعاناة بطريقة رمزية ومؤثرة. وتُعتبر الفنون البصرية بعامة، مثل الرسم والتصوير الفوتوغرافي، مجالًا خصبًا لإيصال واقع المأساة، وتوفر مساحة تفاعلية لإشراك الجمهور بشكل أعمق في أبعادها الإنسانية.
أخيرًا، يتيح التوثيق الصوتي، مثل البودكاست والمقابلات الإذاعية، إمكانية الاستماع إلى قصص وتجارب الضحايا، ما يجعل الجمهور يعيش هذه القصص بشكل أكثر واقعية، ويساعد على تكوين تصوّر أوسع وفهم أعمق للمأساة.
لا شك في أن الغزيّين، من إعلاميين وأفراد ومبدعين، قد أبدعوا، رغم قسوة واقع العدوان والحصار وقلة الإمكانيات، في إيصال معاناة الناس في غزة، وتسليط الضوء على قصص المأساة، ومبادرات الأمل والنجاح أيضًا. لكن، وخلال الشهور الأخيرة، ونتيجة لاستشهاد عدد كبير من الإعلاميين والفاعلين في عملية نقل المعاناة، واشتداد الحصار، وشحّ الإمكانيات، بما في ذلك المواد الأساسية للحياة، تراجع مستوى التنوع في وسائل وأدوات رواية المأساة، وأصبحت الصور ومقاطع الفيديو الخبرية تبدو وكأنها الأكثر سيطرة على المشهد الإعلامي من غزة، وهي، وعلى الرغم من قدرتها على التأثير، لكن يبقى تأثيرها محدودًا ومؤقتًا، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها كوسيلة فعّالة لنقل المعاناة بهدف إيقافها.
لا بدّ إذًا من استراتيجية أكثر شمولية تتضمّن التنوّع في طرق وأدوات نقل المعاناة، يساهم فيها الناشطون حول العالم، من صحافيين ومبدعين، بهدف إثراء المشهدية الإعلامية حول غزة، بما يضمن تجديد وتحفيز حركة التضامن بهدف وقف الإبادة وإغاثة المنكوبين. إضافة إلى أنه يجب استخدام جميع الوسائل المتاحة لإحداث تغيير حقيقي، بما في ذلك: أشكال الاحتجاج الشعبي، كالمسيرات والتظاهرات، والمقاطعة على مختلف المستويات، والضغط الدولي، والتحرك القانوني ضد الإبادة الاستعمارية في غزة.
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center