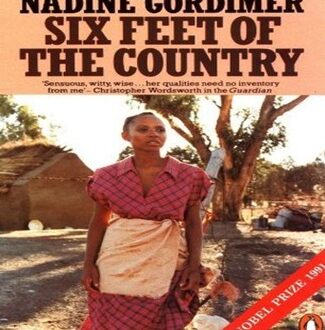استهلال
نادين غورديمر (1923 -2014) كاتبة وروائية من جنوب أفريقيا نالت جائزة نوبل للآداب في العام 1991. توصف بأنها “سيدة الأدب الأفريقي” في حين تصف نفسها بأنها “إفريقية بيضاء”. صدر لها نحو 15 رواية و 15 مجموعة قصصية وبعض الأعمال النقدية. وتتناول في أعمالها قضايا الفصل العنصري والمنفى والاغتراب. وكانت عضواً قيادياً بارزاً في المؤتمر الوطني الإفريقي ومن الأصدقاء المقربين من نيلسون مانديلا. منعت أعمالها من التداول في جنوب إفريقيا في فترة الحكم العنصري للبلاد.
نشرت قصة “ست أقدام بحجم قبر Six Feet of the Country ” في العام 1956 ضمن مجموعة تحمل الاسم ذاته وتضم سبع قصص قصيرة، وتتحدث عن وفاة مواطن أفريقي من روديسيا (حالياً زيمبابوي) يدخل بطريقة غير شرعية إلى اتحاد جنوب أفريقيا بحثاً عن العمل، فيموت في مزرعة رجل أبيض يعمل أخوه فيها، وعندما تحاول عائلته دفنه، وبسبب من سوء الإدارة البيضاء في تنظيم شؤون المواطنين السود يحصلون على جثة أخرى، ورغم محاولاتهم الحثيثة فيما بعد لاستعادة جثة الشاب إلا أنهم لن يفلحوا، رغم المبلغ الباهظ الذي دفعوه مقابل ذلك، وهكذا تخسر العائلة النقود والابن الميت.. ويبقى مكانه غير معروف وقبره مجهول.. مجرد رقم بلا هوية.. أو ربما لا يوجد له قبر، فقد يكون اختفى في مخابر التشريح الجامعية حيث تحول جسده إلى مجرد عينات تدريسية.. هكذا بكل بساطة لا يستطيع المواطن الأصلي أن يحصل ولو على مساحة صغيرة لا تتجاوز المترين كي يستريح فيها جسده في رحلة الحياة الأخيرة.
تستخدم الكاتبة ضمير المتكلم “المفرد غالباً” (مما يوحي بطريقة ما مشاركته في الأحداث أو في صنعها) بلسان رجل أبيض من الطبقة الوسطى، يعيش مع زوجته في مزرعة صغيرة على تخوم جوهانسبورغ، يوظف عمالاً سوداً بينهم بيتروس. كل ما نعرفه عن عالم الفقراء السود يصلنا من خلال صوت الراوي، الذي يتحدث ببرود وبشيء من التهكم، وكأنه يروي تفاصيل حياتية عادية لا مأساة إنسانية.
هذه المسافة الأخلاقية المتعمدة بين الراوي والحدث هي ما يمنح القصة قوتها؛ فالمأساة لا تُقال مباشرة، بل تُرى وهي تُغلف بالكلام اليومي المحايد. موت شقيق بيتروس، وضياع جثته في نظام البيروقراطية البيضاء، لا يتحول إلى «حدث» إلا حين يمسّ الراوي نفسه. وهنا يظهر النفاق البنيوي في المجتمع الاستعماري: الإنسان الأسود يُمحى حتى بعد موته، والبيض يبدون متعاطفين ما دام الألم لا يخلّ بتوازنهم الخاص.
تبني القصة معمارها الدرامي في سياق نظام الفصل العنصري ” الأبارتيد”؛ ويقصد به شكل الحكم السياسي في اتحاد جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 1948 و 1991. فتطرح بعض الأمثلة عن حالات الاضطهاد والظلم ذات الدوافع العنصرية، وتستخدم غورديمر، فشل أحد أنماط مؤسسة الزواج “البيضاء” يربط شخصيتين رئيسيتين في القصة للتدليل على فشل المجتمع في تحقيق المساواة عبر الانفصال الجسدي والعقلية. وهذا يقودنا إلى التعرف على المستويات الدرامية العديدة في القصة مثل الفصل العنصري/ العرقي وهو المستوى الأساسي، ثم العلاقة الزوجية الفاشلة بين زوجين بيض، ثم المستوى الجندري والعلاقة الذكورية المهيمنة والرؤية الدونية للزوجة حين يلمح الراوي في بداية القصة إلى انفصاله “غير الرسمي” عن زوجته حين يؤكد أنه يزور مزرعتهما في المساء فقط؛ وفي عطلة نهاية الأسبوع، كما يلمح إلى تفوقه الذكوري بإصراره على أنه وزوجته ليسا مزارعين حقيقيين “ولا حتى زوجته”؛ وهذا يعني بطريقة لا واعية نظرته المحافظة لها واعتقاده بتفوقه؛ ولعل هذا الخلل يمثل المأزق الوجودي الجوهري للحالة الاستعارية في جنوب أفريقيا في تلك الفترة.
تمثل الزوجة البيضاء (ليريس)، نوعاً من الشفقة المشروطة، لتكون الوجه الآخر للأخلاق الليبرالية البيضاء، بمعنى التعاطف العاطفي المكثف، لكنه عاجز، في ذات الوقت، عن الفعل. انفعالها الصادق يقف عند حدّ المشاعر، فيما يستمر النظام الذي تنتمي إليه في سحق الآخر. عندما يقول الراوي إنها لم تعد تحتمل حتى ابتسامة ساخرة، فهذا يكشف هشاشتها النفسية المتجسدة في شفقة تحولت إلى تبرير للذات، وليس إلى وعي نقدي. ولعل هذا ما يرسخه العنوان وما يحمل من مجازات رمزية عن الجسد المفقود وغياب الوطن، فتداخل الدلالات في العنوان واضحة تماماً فالأقدام الست هي المسافة الأخيرة بين الإنسان والأرض. والوطن هو ما يُحرم منه بيتروس وأمثاله؛ فحتى في موتهم لا يملكون قطعة الأرض يُدفنون فيها.
تضيع الجثة المجهولة بين المقابر أو في كلية الطب كحالة نفي مزدوج للهُوية؛ لا اسم ولا حتى رقم… لا مكان. وكأن النظام الاستعماري لا يكتفي بحرمانهم من حياة كريمة، بل يسلبهم أيضاً حقّ الموت بكرامة. يتشيئ الإنسان الأسود ويتحول إلى “موضوع” “تشريحي” في مخابر كلية الطب أو “رقم” في سجل رسمي
وكما يظهر يبدو لنا الراوي وكأنه ينقل لنا الأحداث كما حدثت بالفعل، ولكن بلسان وعقل وتأويل أبيض استعماري عنصري متعالي (كما هو حال نظرة وفكر وتأويل الاستعمار للعالم) حيث لا يمكن أن تنشأ في أي سياق استعماري علاقات مساواة متكافئة حتى بين المستعمِرين أنفسهم.. وتظهر علامة سيطرته حين يكتشف جثة شقيق بتروس خادمه فيعتبر نفسه بأنه الشخص الوحيد القادر على تسوية المسألة.
تقول غورديمر في أحد حواراتها: “هناك بصمات خفية في ذاكرتي ترغمني على كتابة هذا النوع من الروايات حيث لا أنسى هجوم الشرطة على مربيتي السوداء بتهمة مشروبات كحولية، وأيضاً عدم السماح للسود بدخول المكتبة العامة، فماذا تراني أكتب وأنا أرى الجرائم تنهمر أمامي في الطرقات”. وهكذا سوف نرى التوترات التي يذكرها الضيوف في بداية القصة ذات صلة بالفصل العنصري وآليات الهيمنة العرقية العنيفة الناتجة عنه؛ ومع هذا يعتقد الراوي أنه وزوجته أقاموا علاقة جديدة وأفضل مع المواطنين السود، لا سيما الذين يعملون لديهم. ويمكن فهم ذلك ضمن العلاقة بين الطرفين “البيض والسود” وتأثير الاستعمار في تلك العلاقة حين يجبر السكان الأصليون على هجر عاداتهم وتقاليدهم ولغلاتهم وأديانهم وتبني الجلب الاستعماري الأوروبي “الأبيض” ضمن مفردات رمزية مميزة مثل الصمت والخوف والعنصرية والنفاق وذلك من بين أمور عدة.
وبذلك تكون القصة عن حادثة “سوداء” يرويها شخص “أبيض”، وفي الواقع نكاد لا نرى أو نلمس علاقة حقيقية بين السود والبيض؛ بل إن العلاقة الوحيدة في القصة هي حكاية عائلة بيضاء وعمالها السود، الذين كانوا يقومون بالطهي، التنظيف والبستنة، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لدخول السود إلى اللون الأبيض منازل الناس، ويقع السرد الأساسي للقصة ضمن مساحة “بيضاء” أي في منزل ومزرعة الزوجين البيض؛ أما السود (رجال ونساء وحتى أطفال) فهم من يقومون ببقية الأعمال من طبخ وتنظيف وبستنة.. إلخ. ويشير هذا إلى أن نادين غورديمر التي تدافع عن السود وضد الفصل العنصري ومشاركتها السياسية والاجتماعية ضد نظام الأبارتيد، لا تزال شخصاً أبيض، بريطانية، تنتمي للفئة التي استعمرت البلد. ويظهر هذا واضحاً أكثر في التأكيد على القوة “الموضوعية” التي تتحكم في العلاقة بين البيض والسود، وكيف لا يستطيع السود حتى وإن كانوا هم الأكثرية في فرض رأيهم أو طريقة تفكيرهم أو أسلوبهم في حل المشاكل؛ بل يحتاج الأمر إلى تدخل الرجل الأيض، هذه الفطرة تطرحها غورديمر بشكل صريح في النص.
فالرجل الأبيض هو الوحيد القادر على التحدث مع السلطات والتفاوض معها من أجل استعادة الجثة أو النقود، فضلاً عن اتساع الهوة الثقافية بين الطرفين، فالزوج لا يستطيع أن يفهم كيف ينطوي دفن جثة فتى صغير على تلك الدرجة من الأهمية بحيث يحضر الأب من بلد بعيد (روديسيا) لدفنه وطيف يستغني الجميع عن مدخراتهم من أجل دفن الجثة بطريقة لائقة وفي قبر معروف.. كل هذا غير مفهوم للزوج ولا حتى لزوجته -حسب زعمه- فهؤلاء “الشياطين الفقراء” كما يدعوهم يتخلون عن المال من أجل “ميتة لائقة”، بينما هو يرى في الموت مجرد خسارة نهائية غير قابلة للتعويض وبالتالي لا داعٍ لأن تنطوي عليه أي تكلفة إضافية.
يظهر “الصمت” كإحدى المفردات القوية في العلاقة بين الطرفين -السود والبيض- فالشغيلة السود لا صوت لهم، لا يظهر سوى صوت واحد منهم، بيتروس، حتى في أشد حالات الدفاع عن النفس لا نسمع صوتهم، حين يعرف الزوج أنهم أخفوا عليه خبر الوجود غير الشرعي لشقيق بيتروس، يصمتون تماماً، فتلك المرأة تجيب عن سبب موت الفتى ببعض الإشارات من يديها دون أن تتفوه بحرف واحد، وحتى بيتروس يطول جوابه ولا يتكلم من تلقاء نفسه إلا بعد أن يطلب منه “الزعيم” تقديم التوضيحات المطلوبة، يقدم لنا الراوي أسماء بعضهم لكن لا نسمع صوتهم أبداً ويزيد من سخرية هذا الواقع أن جميع أسماء السود هي أسماء أوروبية “مسيحية”.( ألبرت، فرانز، بيتروس، دورا، جاكوب)، ويبدو أن امتلاك بيتروس لصوت “تمثيلي” باسم السود هو اختيار قصدي من غورديمر كوسيلة متاحة للدفاع عن قضايا السود، واستخدمت الكاتبة شخصية بيتروس لهذا الغرض باعتباره يمثل الصورة الأوضح والأكثر نضوجاً للتعبير عن غضب وخيبة أمل السكان الأصليين من الاستعمار غير المبالي بمشاكلهم وهمومهم، بل يعتبرهم “موضوعات” طارئة بلا قيمة تذكر سوى حامته لهم كقوة أعمل في مطارح يستنكف الرجل الأبيض العمل فيها.
فحتى الخطأ الذي ارتكبته السلطات بتسليمهم الجثة الخطأ، تم الاعتذار عنه بصفته “إجراء” خاطئ ولس بصفته “إهمال” تسبب في آلام معينة، ولعل السلطات تعلم أن الجثة المسلمة ليست جثة شقيق بيتروس بل ربما تعود لمهاجر آخر، وهذا يدل على عدم قيمة “حياة” و “موت” الآخر الأسود، وسوف يكون عدم الاهتمام مضاعفاً حين يمارس على مهاجرين جاؤوا للبحث عن حياة أفضل. لم تمانع السلطات البيضاء في إعطائهم جثة أخرى وأعطتهم أحد المهاجرين الآخرين، الذي لم يكن شقيق بيتروس، ولم يهتموا حتى برأي بيتروس ووالده، الذي جاء من بلاده ليتمكن من دفن ابنه، وهنا ندرك أهمية السود للبيض، فهم لا يعتبرون هباءً، وسيفعلون أي شيء لإبقائهم صامتين.
وسوف تكون “الهوية” إحدى مفردات، بالأحرى موضوعات العلاقة بين السود والبيض في نظام الفصل العنصري. وهي مفردة شديدة الوضوح في القصة
يشعر العامل الأسود بأنه عالق بين عالمين، فهو يعمل لصاحب الرجل الأبيض، لكنه مرتبط بمجتمعه وعائلته، منهم من هو قريب ومنهم من هو بعيد، وتعكس القصة نفاق المجتمع بنبرة تهكمية، حين تبرز التمايز بين العرقين بصفته جزءً من أمن البلد ورفاهية الجميع، في حين يستخدم، في الواقع، للحفاظ على سلطة الأقلية البيضاء، ألم يقل بيتروس بأن الرجل الأبيض يمكنه فعل أي شيء لو أراد، وإن لم يفعل شيئاً فلأنه لا يريد وليس لأنه لا يستطيع.
يتم التعبير عن قوة وسلطة البيض من خلال “انفصال” العائلات، إذ يتعين على الرجال السود الابتعاد عن أسرهم وعن عاداتهم وتقاليدهم وعن بلدهم ولغتهم، سواء بهجرة غير شرعية أو بالسير وراء أسيادهم البيض أرباب العمل وأصحاب المزارع والمناجم وغيرها، من أجل العمل وكسب المال بطريقة ما.
كان الفتى شقيق بيتروس مهاجراً غير شرعي أتى ليعمل في “فردوس” الرفاهية كما كان يطلق، تضليلاً، على جوهانسبرغ، وهو ليس وحده من قام بذلك فالعديد من أبناء العائلات اضطروا للسير أكثر من ألف كيلومتر بحثاً عن العمل وعن تلك “الجنة” في مدينة الذهب.
حاولت في الترجمة الحفاظ على أسلوب الكاتبة المستند إلى المفارقة بين الواقعي والرمزي، وبين النبرة الساكنة والحدث العنيف. فلغة الراوي هادئة، عقلانية، خالية من الانفعال، لكنها تنقل عنفاً مضمراً يظهر في عنف البيروقراطية واللامبالاة، أي عنف الامتياز الأبيض. فقوله: “… ربما في مقبرة متشابهة القبور… أو في كلية الطب حيث يُختزل الجسد في طبقات العضلات وخيوط من الأعصاب”، يحمل دماراً أخلاقياً كاملاً خلف نغمة علمية باردة. وفي نهاية القصة حين تقدم ليريس إحدى بدلات والدها للرجل العجوز القادم من روديسيا، ويعود إلى بلاده “أوفر حظاً مما كان حين جاء”. فرغم “نعومة” هذه العبارة، إلا أنها تحمل سخرية سوداء لاذعة: فالثمن الذي حصل عليه مقابل ابنه هو بدلة قديمة، لا أكثر. فاقتصاد الموت الاستعماري يجسد هنا المعنى الكلي للإزاحة المزدوجة، يسلب الجسد الأسود مرتين، في المرة الأولى في حياته حين تسلب منه أرضه وقوة عمله وفي المرة الثانية في موته حين يسلب منه جسده. ولكن [دائماً هناك ولكن] في المقابل يفقد الضمير الأبيض مرتين: أولاً في صمته، ثم في محاولته الواهنة لتبرير نفسه عبر الشفقة أو البيروقراطية.
تغلق غورديمير القصة بجملة تبدو إنسانية، لكنها في جوهرها اعتراف بالمأساة الأخلاقية للنظام الأبيض الذي لا يرى في حياة السود سوى بضاعة قابلة للمقايضة.
………
ست أقدام بحجم قبر
1
زوجتي وأنا لسنا مزارعين، في الواقع، لم أُخلق لأكون فلاحاً حقيقياً -ولا حتى ليريس.
اشترينا هذا العقار، الذي يبعد حوالي 15 كلم عن جوهانسبرغ عند إحدى الطرق الرئيسة، وكان الأمل، فيما أظن، هو تغيير بعض ما في أنفسنا. فالإحساس بالتقلب المستمر بين الهموم والألم يجعل أي شخص يعيش زواجاً غير مستقر مثل زواجنا يتمنى لو تمر أيامه في صمت عميق مليء بالرضا والهدوء، دون سماع أحد، وهو يتأمل حياته الزوجية. وفي حالتنا، لم تحقق المزرعة هذا الهدوء العميق المنشود وتلك السكينة المطلوبة؛ لكنها قدّمت لنا، بلا ريب، أشياء أخرى، أشياء غير متوقعة وغير منطقية.
انغمست ليريس في إدارة شؤون المزرعة بجديتها المعهودة التي كانت تمنحها في أداء الشخصيات المسرحية كما يتصورها الكاتب تماماً في ذهنه؛ وهي التي اعتقدت أنها ستمضي تقاعدها في هذه المزرعة، وتعيش لمدة شهر أو شهرين في حزن يشبه حزن أبطال قصص أنطون تشيخوف، ثم تترك المكان للخدم لتجرب مجدداً الحصول على دور ترغب فيه وتصبح الممثلة التي تتمنى أن تكونها.
ولولا وجودها هنا، في المزرعة، على تلك الحالة والهيئة، لما كنت بقيت لحظة. ولكنت قد غادرت منذ زمن بعيد، لولا تعلقها العميق بتفاصيل الحياة في هذا المكان.
أصبحت يداها، تلك اليدين الصغيرتين والبسيطتين والرقيقتين، صلبتين مثل وسائد الكلاب من كثرة انشغالها بأعمال المزرعة. ورغم اعتناءها بأصابعها، إلا أنها لم تكن بأي حال من نوع الممثلات اللاتي يضعن الطلاء الأحمر والخواتم المرصعة بالماس.
أما أنا، فاقتصر وجودي في أوقات المساء وفي عطلة نهاية الأسبوع، ويعود هذا، بطبيعة الحال، إلى عملي في مكتب وكالة سفريات فاخرة وناجحة، التي لا بد من أن تكون ناجحة؛ على الأقل لتحمل تكاليف المزرعة، كما كنت أقول دائماً إلى ليريس، مع علمنا بصعوبة، بل ربما باستحالة، تنظيم نفقاتنا عليها حسب ميزانيتنا.
ورغم أن رائحة الطيور الزكية التي تربّيها ليريس تشعرني بالغثيان، حتى أنني كنت أحرص على عدم المرور قرب أقفاصها، فقد كانت المزرعة جميلة، على نحو كنت قد غفلت عنه لمدة طويلة، لا سيما في أيام الأحد، حين كنت أنهض صباحاً، وأخرج إلى الحقل. وطبعاً، لم أكن أتوقع رؤية صف من أشجار النخيل وحوض سمك ووعاء الماء الحجري المزخرف المخصص للطيور كما في الضواحي، بل ستبتل عيناي بمنظر الإوز الأبيض في البركة، وحقل البرسيم الرائع مثل العشب اللامع الذي يزين واجهات النوافذ، ولا بد من أن ألمح ثوراً صغيراً قصيراً ممتلئ الجسم، تضج عيناه القاسيتان بالشهوة والضجر، وبين الحين والآخر كان يلعق إحدى البقرات -سيداته الحسان- القريبات بحنان ولطف. ومن بين كل هذه تخرج ليريس بشعر غير ممشط تحمل بيدها عصا تقطر منها سائل مبيد الحشرات تستخدمه لتطهير الماشية. ستقف برهة، كما العادة، ثم تحدق بحلم للحظة، بالطريقة ذاتها التي كانت تتظاهر بتأديتها أحياناً في تلك المسرحيات؛ ثم تقول: “سيتزاوجان غداً.. هذا يومهما الثاني معاً. انظر كيف يحبها… يا نابليون الصغير المحبوب”.
وعندما يحل موعد زيارات أمسيات أيام الأحد، ويأتي الناس إلى هنا، غالباً ما أجد نفسي أقول وأنا أسكب المشروبات: “عندما أعود يومياً إلى المنزل بعد يوم عمل طويل في المدينة، وأمر بتلك الصفوف الممتدة من المنازل في الضواحي، أتساءل في نفسي كيف تحملنا هذا المكان؟ كيف صمدنا هنا؟ هل ترغبون في التجول قليلاً”؟.
وهكذا أرافق فتاة جميلة وزوجها الشاب بينما أراهما يترنحان على ضفاف نهرنا، وتعلق جوارب الفتاة بأكوام الذرة، وتخطو بحذر فوق روث البقر، الذي يطوف فوقه موجة من الذباب الأخضر اللامع، وهي تقول ” “مشاغل وضغوط المدينة المرهقة، ومع ذلك أنتم قريبون منها بما يكفي للذهاب ومشاهدة أي عرض يخطر ببالكم كلما شئتم! أليس كذلك؟ أعتقد هذا أمراً رائعاً. لديكم الخياران معاً!”
وللحظة، أشعر بالانتصار وكأنني حققت المستحيل، ذلك المستحيل الذي سعيت إلى نيله طيلة حياتي، أقبله وكأن الحقيقة تكمن في أنه يمكنك الحول على “الخيارين معاً”، بدلاً من أن تجد نفسك محاصراً بين طريقين لم تهيئ نفسك لهما، فتجد نفسك مجبراً على سلوك طريقاً ثالثة لم تكن قد أعددت لها حساباً.
ولكن حتى في لحظات وعينا الأكثر صفاءً، حين أجد حماسة ليريس العفوية مزعجة تماماً كما كنت أجد انفعالاتها المسرحية فيما مضى، وحين تعتبر هي ما تسميه “غيرتي” من قدرتها على الحماسة دليلاً كبيراً على عدم ملاءمتي لها كشريك، تماماً كما كان الحال دائماً، فإننا نؤمن، على الأقل، بأننا نجحنا في الهروب بصدق من تلك الضغوط الخاصة بالمدينة التي يتحدث عنها زوارنا.
وعندما يتحدث سكان جوهانسبرغ عن “التوتر”، فهم لا يقصدون الزحام والوجوه المتعجلة في الشوارع المكتظة، أو الصراع من أجل المال، أو الطابع التنافسي العام للحياة الحضرية. بل يعنون الأسلحة المخبأة تحت وسائد الرجال البيض والقضبان الحديدية المثبتة على نوافذهم. إنهم يقصدون تلك اللحظات الغريبة على أرصفة المدينة عندما يرفض رجل أسود التنحي جانباً لرجل أبيض.
تبدو الحياة في الريف أفضل من ذلك، حتى على بعد بضعة كيلومترات عن المدينة. فلا تزل هناك بقايا متبقية من المرحلة السابقة على التحولات الاجتماعية؛ علاقتنا مع السود تكاد تكون شبه إقطاعية. قد يكون ذلك خاطئاً، ويبدو كأنه ينتمي إلى زمن آخر، لكنه، في النهاية، أكثر راحة للجميع. هنا لا نضع قضباناً حديديةً على نوافذنا ولا نخبئ أسلحة تحت وسائدنا. العمال الشباب في مزرعة ليريس يعيشون مع زوجاتهم وأطفالهم في المكان ذاته. يخمرون بيرة الذرة الحامضة دون خوف من مداهمات الشرطة. في الواقع، كنا نشعر دائماً بشيء من الفخر لأن هؤلاء المساكين ليس لديهم الكثير ليخشوه ما داموا معنا؛ حتى أن ليريس تراقب أطفالهم بعناية، بحس امرأة لم تنجب قط، وتعالجهم جميعاً -صغاراً وكباراً- كما لو كانوا رضعاً، كلما ألمّ بهم المرض.
ولهذا لم نفاجأ كثيراً حين جاء، ذات ليلة في الشتاء الماضي، الصبي ألبرت يطرق نافذتنا بعد وقت طويل من ذهابنا إلى الفراش. لم أكن نائماً في سريرنا حينها؛ بل كنت نائماً في غرفة الملابس الصغيرة المجاورة، لأن ليريس قد أزعجتني، ولم أرد أن أجد نفسي ألين تجاهها لمجرد رائحة بودرة “الطلق” الزكية التي كانت تفوح من بشرتها بعد استحمامها.
هرعت ليريس لتوقظني وهي تقول: “ألبرت يقول إن أحد الأولاد مريض جداً. أرى من المناسب أن تنزل لترى ما الأمر، لن يوقظنا في هذا الوقت المتأخر من أجل لا شيء، لا بد من أن الأمر مهماً على الأرجح”
-كم الساعة؟
-ماذا يهم لو عرفت؟
هكذا هي ليريس، كانت تثير جنوني بمنطقها القاسي.
نهضت من فراشي بتثاقل تحت أنظارها، مرتبكاً بعض الشيء وهي ترمقني بحدة – لا أدري لماذا أشعر دائماً بالحمق حين أترك فراشها!. أعلم تماماً أنها بالجرح والإهانة حين أدير لها ظهري في الليل وأتركها تنام لوحدها في السرير، وأدرك ذلك من طريقتها الباردة في الحديث معي صباح اليوم التالي، من دون أن تنظر إليّ
خرجت مترنحاً من النعاس، ورافقت ألبرت على ضوء المصباح اليدوي المتراقص أمامنا، وسألته :”من هو المريض؟؟
-إنه مريض جداً. مريض جداً، يا “زعيم”*.
-نعم.. نعم.. ولكن من؟ من هو؟ هل “فرانز”.. ثم تذكرت أن فرانز يعاني من سعال شديد منذ أيام.
لم يقل شيئاً، وقد أفسح لي الطريق وسار بمحاذاتي وسط العشب الجاف. وعندما لامس نور المصباح وجهه، رأيت عليه ارتباكاً شديداً، فسألته:
-“ما بك يا ألبرت؟ ما الأمر؟”. خفض رأسه مبتعداً عن الضوء وقال: لست أنا السبب يا “زعيم” لست أنا، لا أعرف شيئاً. بيتروس هو من أرسلني”
شعرت بالضيق، فحثثته على الإسراع إلى الأكواخ.
وهناك، على سرير بيتروس المعدني المرتكز على قوالب من الطوب، كان شاب ممداً، ميتاً.
جبهته مبللة بقطرات عرق خفيفة، وجسده لا يزال دافئاً، وقف حوله الصبية كما يقفون في المطبخ، صامتين محرجين، عندما يُكتشف أن أحدهم كسر شيئاً. في الظلال، وقفت امرأة، ربما زوج أحدهم، تعتصر يديها تحت مئزرها.
لم أرَ رجلاً ميتاً منذ الحرب. لكن هذا بدا مختلفاً. شعرت، كما الآخرون، بأني غريب تماماً، ومعدوم الفائدة. فقلت
-ما الذي حدث؟
Top of Form
ربتت المرأة على صدرها وهزت رأسها كأنها تشير إلى استحالة التنفس وشدة الألم. لا بد أنه مات بالتهاب رئوي.. هكذا تكهنت وأنا التفت إلى بيتروس وأساله
-من هذا الغلام! وماذا يعمل هنا.
كانت شمعة موضوعة على الأرض تلقي ضوءً خافتاً على وجهه. في ذلك الوميض العابر رأيت أنه كان يبكي. خرجت من الكوخ وتبعني. وقفنا في الظلام، وانتظرت أن بتكلم، لكنه ظل ساكناً، مطأطئ الرأس
– هيا يا بيتروس، أخبرني، من يكون هذا الفتى، وما قصته؟ هل هو صديقك؟
رفع عينيه وقال بصوت بالكاد يُسمع
-إنه أخي يا “زعيم”.. شقيقي جاء من “روديسيا” يبحث عن عمل.
2
أذهلتنا القصة -ليريس وأنا- ولو قليلاً. لقد جاء الفتى ماشياً على قدميه من روديسيا إلى جوهانسبرغ بحثاً عن عمل. وقد أصابه البرد -كما يبدو- بسبب النوم في العراء على الطرقات، ومنذ أن وصل، قبل ثلاثة أيام، وهو مريض طريح فراش شقيقه بيتروس.
لم يجرؤ عمالنا على إبلاغنا، لأنهم لم يرغبوا في كشف أمره، فالقانون يمنع دخول السكان الأصليين من روديسيا إلى الاتحاد دون تصريح.
الشاب كان مهاجراً غير شرعي، هذا واضح.
ولا شك أن رجالنا سبق أن دبروا مثل هذه الترتيبات من قبل، ونجحوا فيها؛ فلا بد أن أقرباء كثيرين سبق لهم أن قطعوا تلك الرحلة الطويلة، ما يزيد عن ألف كيلومتر هرباً من الفقر إلى فردوس الرفاهية والثراء** المزعوم: إيغولي***، مدينة الذهب، حيث لا ينتظرهم إلا مداهمات الشرطة وضواحي الصفيح الفقيرة التي يقطنها السود الفقيرة،.
عادة ما كانت تتم الأمور بهذه الطريقة، يحضر أحدهم من روديسيا فيعبر الحدود بشكل غير شرعي؛ ثم يختبأ في إحدى المزارع، مثلما حصل معنا تماماً، ويبقى متخفياً حتى يعثر له أحدهم على عمل عند شخص لا يمانع من المخاطرة في توظيف مهاجر غير شرعي لم يتلوث بطباع المدينة. وهذا ما حصل للفتى… لكنه لن يقوم ثانية.
حسناً، هذا فتى لن يقوم مرة أخرى أبداً
في صباح اليوم التالي، بادرتني ليريس بسؤالـ بعينين متقدتين، عما إذا كنت أظن أنه كان ينبغي عليهم إخبارنا بمرض شقيق بيتروس، على الأقل بمجرد أن ساءت حالته.
عندما تصبح ليريس متحمسة لأمر ما، تقف في وسط، تحدق بالأشياء المألوفة حولها كما لو أنها تراها للمرة الأولى، وكأنها على وشك الانطلاق في رحلة قصيرة.
لاحظت قبل قليل كيف بدا الاستياء والإحساس بالإهانة يعلو ملامحها من خلال تعابيرها حين كان بيتروس في المطبخ
لم أملك الوقت أو المزاج للخوض في كل تفاصيل حياتنا التي أعلم أنها تود أن نغوص فيها. أعرف ذلك من نظراتها الملحة، من تلك العيون التي تكاد تتوسل. هي من النساء اللواتي لا يمانعن أن يبدين عاديات أو غريبات، وربما لا يهمها كيف يبدو وجهها حين يغلبه القلق وعدم اليقين.
قلت لنفسي، أو ربما لها: ” على ما يبدو، سأكون أنا من يتولى القيام بكل الأعمال القذرة هذه المرة”.
كانت لا تزال تحدق بي. تختبرني بتلك العيون -يا لها من مضيعة للوقت لو كانت تعلم.
قلت لها بهدوء محاولاً عدم فضح تمللي: “سأضطر لإخطار السلطات الصحية. لا يمكنهم أخذ الجثة ودفنها هكذا. ففي النهاية، ما زلنا لا نعرف سبب وفاته”
ظلت واقفة هناك بمكانها صامتة، كما لو أنها قد استسلمت تماماً، وكأنها توقفت عن رؤيتي بكل معنى الكلمة.
لم أعش شعور الغضب هذا منذ زمن طويل. فقلت دون انتظار جواب منها “قد يكون شيئاً معدياً، من يدري؟”… وطبعا لم ترد. لستُ من محبي الحديث مع نفسي. دلفت إلى الخارج لأصرخ في أحد الفتيان أن يفتح المرآب ويجهز السيارة لجولتي الصباحية إلى المدينة.
3
ومثلما توقعت، تبين لي أن الأمر كان معقداً ويحتاج وقتاً وجهداً كبيرين. كان علي إخطار الشرطة والسلطات الصحية، والإجابة على الكثير من الأسئلة المملة: كيف لم أعلم بوجود الصبي؟ وإذا لم أشرف شخصياً على مساكن العمال، فكيف علمت أن أموراً من هذا النوع لا تحدث طوال الوقت؟ .. وغيره وغيره من الأسئلة. وعندما انفجرت وأخبرتهم أنه طالما يقوم عمالنا بأشغالهم على أكمل وجه، فليس من حقي أو من شأني التدخل في شؤونهم الخاصة، رمقني الرقيب الفظ والبليد بنظرة تمزج بين الازدراء والبهجة لغبائي، نظرة لا تنبع من أي تفكير حقيقي، بل من ذلك الفهم الغريزي المشترك لدى من يؤمنون بنظرية التفوق العرقي.. تلك النظرة الممزوجة باليقين الغبي الجنوني.
ثم كان علي أن أشرح لبيتروس لماذا يتوجب على السلطات الصحية أخذ الجثة لإجراء التشريح اللازم للتعرف على سبب الوفاة، وأن أشرح له ما معنى “التشريح” أصلاً.
بعد أيام، اتصلت بدائرة الصحة لأعرف نتيجة الفحص والتشريح، فقيل إن سبب الوفاة، كما كنا نعتقد، الالتهاب الرئوي، وأن الجثة قد “جرى التعامل معها على النحو المناسب”.
خرجت إلى الفناء، حيث كان بيتروس يخلط العلف للدجاج، وأخبرته أن كل شيء على ما يرام، وأنه لن تكون هناك أية مشكلة؛ فشقيقه مات بسبب ذلك الألم في صدره.
وضع بيتروس علبة الكيروسين القصديرية جانباً وقال بهدوء
-متى يمكننا الذهاب لإحضاره يا “زعيم”
-إحضاره.
-هل يتكرم “الزعيم” بالسؤال متى يجب أن نأتي؟
عدت إلى الداخل وناديت ليريس، في أرجاء البيت، فأتت تهبط الدرج المؤدي إلى غرف الضيوف، ولما وقفت أمامي قلت: “أخبريني الآن، ماذا علي فعله؟ عندما أخبرت بيتروس ما قالته السلطات ، فسألني بهدوء متى يمكنهم الذهاب وجلب الجثة. يظنوا أنهم سيقومون بدفنه بأنفسهم”.
-عد وأخبره بحقيقة الأمر.. عليك أن تفعل، لماذا لم تخبره في حينه؟.
خرجت من جديد، ولما وجدته، رفع نظره نحوي بأدب، فقلت: “انظر يا بيتروس.. لا يمكنك إحضاره. لا يمكن.. لقد دفنوه، لقد فعلوا ذلك، هل تفهم ما أقول”؟
-أين دفنوه؟ قالها ببطء وبنغمة خافتة خالية من الحياة، كما لو كان يشك في أنه أساء الفهم.
-كما ترى، لقد كان غريباً عن المنطقة. عرفوا أنه ليس من هنا، ولم يعلموا أن له أهلاً يقيمون في الجوار، فرأوا أنه لا بد من دفنه هناك على طريقتهم”.
كان من الصعب أن أجعل “قبر الفقراء” يبدو كأنه امتياز.
– أرجوك يا “زعيم”، اسـالهم، أرجوك أن تسألهم، على “الزعيم” فعل ذلك.
لكنه لم يكن يقصد معرفة موضع القبر. لم يكن يعني ما ظننته. كان يتجاهل كل تلك الآليات الغامضة التي أخبرته أنها تولت أمر شقيقه الميت، كان يريد فقط أن يعود شقيقه إليه.
– ولكن يا بيتروس، كيف يمكنني ذلك؟ لقد دفن أخوك بالفعل، لا أستطيع الآن أن أطلب منهم شيئاً كهذا.
“آه، يا “زعيم”! قالها بصوت متهدج، ووقف ويداه الملطختان بالعلف متراخيتان على جانبيه، وقد بدأت ترتعش إحدى زوايا فمه.
– يا إلهي يا بيتروس، لن يصغوا إلي! ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي حال. أنا آسف، ولكن لا أستطيع. هل فهمت”؟ قلت ذلك محاولاً أن أبدو حازماً وأنا أكاد أختنق من شدة الضيق.
ظل يحدق فيّ بتلك النظرة التي يعرفها كل من عاش طويلاً بيننا؛ نظرة الإيمان بأن الرجال البيض يملكون كل شيء، ويقدرون على كل شيء؛ وإن لم يفعلوا، فذلك لأنهم لا يريدوا.
وبعد ذلك، في العشاء، بدأت ليريس الحديث فجأة
– كان يمكنك على الأقل الاتصال بهم هاتفياً
فانفجرت قائلاً
– بربك يا ليريس، ماذا تظنينني؟ أتراكِ تتوقعين مني إعادة الموتى للحياة؟
لكنني لم أستطع المبالغة لأتخلص من هذه المسؤولية السخيفة التي ألقيت على عاتقي، وعادت ليريس إلى الحديث قائلة:
– طيب! اتصل بهم.. على الأقل، وبهذا تكون قد فعلت ما بوسعك، وسيكون لديك ما تخبره به.. وسيشرحون لك استحالة استعادة الجثة. قالت ذلك ثم اختفت، بعد القهوة، في أركان المطبخ قبل أن تعود بعد لحظات وتخبرني أن “الأب العجوز قام من روديسيا ليحضر الجنازة. لقد حصل على تصريح وهو بالفعل في طريقه إلى هنا”.
ولكن لسوء الحظ، لم يكن استرجاع الجثة مستحيلاً كما توقعت. فقد أوضحت لي السلطات أن الأمر ينطوي على مخالفة إجرائية بسيطة، ولكن بما أن الشروط الصحية قد استوفيت، فلا يمكنهم رفض الإذن بنبش القبر واستخراج الجثمان. وعرفت منهم، لاحقاً أن التكاليف، مع أجور متعهد الدفن، تبلغ عشرين جنيهاً. فقلت في نفسي: آه.. حسنٌ، هذا يحسم الأمر. فبيتروس الذي لا يتجاوز دخله خمسة جنيهات شهرياً، لن يكون قادراً على جمع عشرين جنيهاً، وربما كان ذلك أفضل، إذ لا معنى لهدر هذا المال على الموتى. وبالطبع، لم يخطر ببالي أن أقدم المبلغ من جيبي، عشرون جنيهاً، أو أي مبلغ آخر ولو في حدود المعقول. ولو يعود الأمر لي كنت لأنفقه دون تردد على طبيب أو دواء ربما أنقذا الصبي وهو حي. ولكن بعد أن مات، لا نية لدي لتشجيع بيتروس على تبديد مبلغ يفوق ما يكسو به أسرته كلها لعام كامل، من أجل نزوة أو بادرة رمزية لا طائل منها. وحين أخبرته، في المطبخ في تلك الليلة، قال:
-عشرين جنيهاً؟
– نعم، هذا صحيح، عشرين جنيهاً. وشعرتُ، للحظة، من مظهر وجهه، وملامحه، أنه كان يحسب المبلغ في ذهنه. لكنه عندما تكلم مجدداً، ظننت أنني ربما توهمت، فقد قال بصوت بعيد، كأنه يتحدث عن شيء بعيد المنال، لا يحتمل مجرد التفكير فيه:
-علينا أن ندفع عشرين جنيها!.
– لا بأس يا بيتروس.. لا بأس
ثم عدت إلى داخل البيت
في صباح اليوم التالي وقبل ذهابي إلى المدينة، طلب بيتروس رؤيتي، ولما التقينا، قال متلعثماً وهو يناولني بارتباك واضح رزمة من الأوراق النقدية:
-من فضلك، يا “زعيم” خذها
في العادة هم من يكونوا في هذا الجانب، أي جانب من يتلقى النقود وليس من يدفعها. نادراً ما يكون أمثالهم في موقع “المانح” وليس “الآخذ”، أمثال هؤلاء المساكين هم من اعتادوا تلقي النقود لا دفعها، ولهذا لم يعرف بيتروس حقاً كيف يقدم المال برجل أبيض.
كانت هناك العشرون جنيهاً كاملةً، من فئتي الجنيه ونصف الجنيه، بعضها مجعد ومطوي حتى صار ليناً كالخرق المتسخة، وبعضها الآخر أملس وجديد نسبياً. قلت في نفسي نقود من هذه؟ من أين جمعها؟ هل هي من فرانز؟ أم من ألبرت؟ أم من الطاهية دورا، ويعقوب البستاني، وربما من آخرين لا يعلمهم إلا الله، بل ربما من جميع المزارع والحواكير الصغيرة المحيطة في الجوار.
تناولت المبلع بنوع من الانزعاج الواضح أكثر من الدهشة، بل في الواقع بضيق شديد من هذا الهدر العبثي، ومن تضحيتهم البائسة وهم يغرقون في فقرهم المدقع. تماماً مثل الفقراء في كل مكان.. حين يضيّقون على حياتهم ويحرمون أنفسهم من أبسط ما يجعل الحياة محتملة، ليضمنوا لأنفسهم شيئاً من “كرامة الموت” بطريقة لائقة. كم يبدو هذا عصياً على الفهم بالنسبة لأمثالنا، أنا وليريس، نحن الذين ننظر إلى الحياة كأنها شيء يمكن إنفاقه بسخاء وإسراف، أما الموت.. إن خطر ببالنا، فهو في نظرنا الإفلاس الأخير والنهائي.
4
في العادة لا يعمل الخدم عصر السبت، لذلك بدا اليوم مناسباً للجنازة. استعار بيتروس ووالده عربتنا مع الحمار، وانطلقا إلى المدينة لإحضار التابوت. وعندما عادا، أخبر بيتروس ليريس أن الأمور سارت على ما “يرام”، لقد كان التابوت، بانتظارهما مغلقاً بإحكام كي لا يضطرا إلى مواجهة المنظر الكريه الذي لا بد أنه حل بالجثة، خاصة وقد مضى نحو أسبوعين كاملين على دفنها، وهو الوقت الذي استغرقته السلطات ومتعهد الدفن للقيام لإنهاء جميع الترتيبات الرسمية لاستخراجها ونقلها؟
كان التابوت يرقد طوال صباح ذلك السبت في كوخ بيتروس، في انتظار الرحلة إلى المقبرة الصغيرة القديمة الواقعة عند الطرف الشرقي لمزرعتنا، تلك البقعة الباقية من الأيام التي كان فيها هذا المكان منطقة زراعية حقيقية، قبل أن يتحول إلى ضيعة ريفية أنيقة الطابع.
وكان من قبيل الصدفة البحتة أن وجدت نفسي هناك، قرب السياج، حين مر الموكب. فقد نسيت ليريس وعدها لي مجدداً، وجعلت المنزل غير صالح للعيش في ظهيرة السبت.
عدت إلى المنزل وقد اشتعل غضبي حين رأيتها أمامي ترتدي سروالاً قديماً متسخاً وشعرها غير ممشط منذ ليلة أمس، وتشرف على كشط طلاء الأرضية الخشبية في غرفة الجلوس كما لو كانت تدير ورشة.
تناولت مضرب الغولف وخرجت أتدرب وحدي. وقد نسيت، في غمرة انزعاجي أمر الجنازة تماماً، ولم أنتبه لها إلا عندما رأيت الموكب يتقدم على الطريق بمحاذاة السور الخارجي باتجاهي. ومن حيث كنت أقف، كان بالإمكان رؤية القبور بوضوح؛ كانت الشمس، في ذلك اليوم، تلمع فوق شظايا الفخار المكسور وصلبان خشبية مائلة في الشكل صنعها السكان المحليين وعلب مربى قديمة بنية اللون بفعل الصدأ الناجم عن الأمطار وبعضة زهور ذابلة فقدن لونها منذ زمن.
شعرت بشيء من الارتباك، ولم أدرِ ما إما كان عليّ متابعة ضرب كرة الغولف أم أتوقف احتراماً، على الأقل حتى يمر المشيعون. كانت عربة الحمار تصدر صريراً حاداً مع كل دورة من عجلاتها، تتقدم متراً، ثم تتوقف برهة، ثم تتقدم لتتوقف من جديد، في حركة متقطعة بدت متناغمة مع حركة سير الحمارين اللذين يجرانها. كان بطن كل منهما صغيراً ومنتفخاً، يغطيه شعر متسخ وخشن من شدة الاحتكاك والفرك، ورأسيهما منحنيتين بين العوارض الخشبية الطولية التي تسند العربة، وآذانهما مطوية إلى الخلف في خضوع كئيب مثير للشفقة.
بدا سير الحمارين البطيء والملول منسجماً، على نحو غريب، مع حركة الرجال والنساء الذين تبعوا العربة على مهل، في صف ثقيل الخطى. تأملت الحمار لحظة، وفكرت، كيف أصبح هذا المخلوق الصابر رمزاً في الكتاب المقدس.
وحين بلغ الموكب مكاني، توقفت الجنازة، فوضعت مضرب الغولف جانباً. أنزلوا التابوت عن العربة -كان من خشب لامع مطلي بورنيش أصفر، كقطعة أثاث رخيصة- فيما كان الحماران يحركان آذانهما ويقوسونها لصد الذباب.
رفع بيتروس وفرانز وألبرت والأب العجوز القادم من روديسيا التابوت على أكتافهم وواصل الموكب حركته سيراً على الأقدام.
كانت تلك لحظة محرجة حقاً.
وقفتُ عند السور أحدق نحوهم بلا حراك، بينما مروا أمامي واحداً تلو الآخرمام، دون أن يرفع أحدهم نظره نحوي. أربعة رجال انحنوا تحت الصندوق الخشبي اللامع، تتبعهم جموع المودعين المبعثرين. كانوا جميعهم من الخدم ممن يعملون في مزرعتنا أو في المزارع المجاورة، أعرفهم معرفة سطحية. أناس بسطاء يتبادلون الأحاديث والثرثرات قرب الحقول أو أثناء ترددهم على مزرعتنا، أو الدخول لمطبخنا لقضاء شؤونهم اليومية أو طلب بعض الأمور
وفي أثناء مرور الجنازة تناهى إلى مسامعي، رغم المسافة، صوت أنفاس الرجل العجوز المتقطعة.
وبينما كنت قد انحنيت ألتقط مضربي من جديد، حدث انقطاع مفاجئ في سير الموكب، وسرى بين الحاضرين اضطراب وقلق، وانتشر أجواء التوتر بينهم، كأنما تسربت موجة حرارة عبر الهواء، أو اندفعت نسمة باردة خفيفة تمس ساقيك وأنت واقف في مجرى ماء ساكن.
كان الرجل العجوز يتمتم بشيء ما؛ فتوقف الناس، مرتبكين، واصطدم بعضهم ببعض، منهم من أراد متابعة السير، وآخرون أشاروا إليهم أن يلتزموا الصمت. بدا عليهم بعض الحرج، لكنهم لم يستطيعوا تجاهل صوته؛ كان كصوت نبي يهذي، غامضاً في بدايته، لكنه يشد الذهن إليه بقوة خفية.
كان زاوية التابوت من جهة الرجل العجوز قد مالت بوضوح، كأنه يحاول التحرر من ثقلها، ورأيت بيتروس يقترب بانفعال مكتوم، يحاول إقناعه أو تهدئته. في تلك اللحظة أسقط الطفل الذي كان يراقب الحمارين اللجام وركض نحو الجنازة ليستطلع ما يحدث. لا أدري لماذا لم أحتمل المنظر، ففعلت كما فعل الصبي وفتحت أسلاك السياج فمررت منها ومضيت حيث كانت تقف الجنازة. كما لو أنني مدفوع بغريزة المشاهدة ذاتها التي تدفع الناس إلى التجمهر حول من أغمي عليه في قاعة سينما.
رفع بيتروس عينيه نحوي -نحو أي شخص- بعينين مملوءتين فزعاً وحيرة.
كان العجوز القادم من روديسيا قد أفلت قبضته تماماً، فعجز الآخرون عن رفع التابوت وحدهم، ووضعوه على الأرض في منتصف الطريق، بينما تصاعد غبار خفيف يرفرف برفق على جوانبه اللامعة. لم أفهم ما الذي كان يقوله العجوز، وترددت في التدخل. لكن الجمع المضطرب استدار، كأن صمتي صار ذنباً. اقترب مني العجوز، ومد يديه نحوي وهو يتكلم إلي مباشرة، لم أفهم كلماته، لكن نبرته وحدها كانت كافية لإدراك أن ما يقوله فظيع وصاعق.
فالتفتت نحو بيتروس وقلت مستفهماً
– ما الأمر يا بيتروس ؟ ما الخطب! ماذا حصل للعجوز؟
طوّح بيتروس كلتا يديه في الهواء، وهز رأسه مراراً في انفعال هستيري، ثم رفع وجهه نحوي فجأة وقال: “يقول إن ابنه لم يكن ثقيلاً بهذا الحجم”.
وساد صمت ثقيل بين الجميع، وكنت ما زلت أسمع صوت نفس الرجل العجوز في صدره، وقد أبقى فمه مفتوحاً قليلاً، كما يفعل كبار السن. ثم نطق أخيراً بالإنكليزية: “ابني كان شاباً نحيلاً”
سقط الصمت بيننا من جديد. ثم انفجر اللغط. فزمجر العجوز في وجوههم ينهرهم، كاشفاً عن اسنانه المصفرة القليلة الباقية في فمه الذي يعلوه شارب طويل مقوس بلون الغبار والشيب، يحاكي شوارب رجال الإمبراطورية الأوائل، نادر الوجود في هذا الزمن، وقد بدا كأنه يمنح كلام صاحبه وزناً خاصاً ومهابة تلقائية، ربما لأن الشارب يرمز إلى الحكمة التقليدية التي ينسب إليها وقار الشيخوخة، تلك الفكرة المتجذرة بعمق، ما تزال تبعث رهبة تتجاوز حدود العقل.
صدمهم حقاً؛ ظنوه فقد صوابه، لكنهم لا يملكون إلا أن يصغوا إليه.
ثم بدأ، بيديه المرتجفتين، يرفع غطاء التابوت، فتقدم نحوه ثلاثة من الرجال لمساعدته. جلس بعدها على الأرض منهكاً، ضامر القوة، عاجزاً عن النطق، واكتفى بأن أشار بيده المرتجفة نحو التابوت المفتوح الآن أمامه، كأنه يسلم الأمر لغيره بعدما أنهكه العجز، كمن تنازل عن آخر ما بقي له من سلطة.
تجمع الحشد حول التابوت يتطلعون إلى ما بداخله- وأنا معهم- وقد غاب عنهم للحظات معنى الفاجعة ذاتها، وذهلوا عن الحزن الذي هم فيه والذي جاؤوا أصلاً من أجله.
تحول المشهد كله إلى انبهار طفولي غامر، مزيج من الذهول والمتعة والدهشة؛ ارتفعت أصواتهم بالشهقات والنداءات، وارتسم على وجوههم انفعال غريب. حتى الصبي الصغير الذي كان يمسك بالحمارين أخذ يقفز في مكانه غاضباً، وكاد يبكي من شدة غيظه لأن أجساد الكبار حجبت عنه المشهد.
في داخل التابوت كان يرقد شخص لم يره أحد من قبل، رجل ضخم البنية، فاتح البشرة نسبياً من السكان الأصليين، وثمة على جبهته أثر جرح قديم خيط بعناية، ربما من ضربة تلقاها في شجار، خلفت إصابة أخرى أبطأ عملاً، هي التي أجهزت عليه بصمت في نهاية الأمر.
5
أمضيت أسبوعاً كاملاً أجادل السلطات بشأن تلك الجثة. كان يخالجني إحساس بأنهم صُدموا، أو ربما مذهولون بطريقتهم الجافة المقتضبة، من خطأهم هذا، لكنهم بدوا في حيرة من أمرهم، عاجزين عن تصحيح ما ارتكبوه وسط فوضى الجثث المجهولة التي اثرت حولها كثيراً من اللغط. كانوا يؤكدون لي أنهم يحاولون، قدر المستطاع، معرفة ما حصل حقاً، وأنهم سيحققون بالأمر كما ينبغي.
كان الأمر أشبه بأن يدخلوني في أي لحظة إلى المشرحة ويقولون “انظر هناك! ارفع الأغطية… ابحث عنه -شقيق صبي الدواجن هذا، فهناك وجوه سوداء كثيرة – ألا يكفيك واحد منها”؟
وفي كل مساء، حين أعود إلى المزرعة، أجد بيتروس بانتظاري في المطبخ. فأقول له: “إنهم يحاولون يا بيتروس. ما زالوا يبحثون، لا تقلق، “الزعيم” يتابع الأمر بنفسه من أجلك. ثم ألتفت إلى ليريس في محاولة لتبرير ضجري “يا إلهي، لو تعلمين، لعلي صرت أقضي نصف وقت عملي في التجوال بسيارتي على أطراف المدينة بسبب هذه القضية التافهة”
كانت ليريس تتابعني بنظرات ثابتة، وكذلك بيتروس. كانا ينظران إلي في صمت، وللحظة خيل إلي أنهما متشابهان على نحو غريب، وجهان يكادان يتطابقان رغم استحالة ذلك، فزوجتي ذات جبهة بيضاء عالية وجسد إنكليزي نحيل، وصبي الدواجن بقدميه الحافيتين المشققتين وسرواله الكاكي المربوط عند الركبة بخيط، وتلك الرائحة النفاذة القوية المنبعثة من جلده، رائحة تشبه عرق الخوف.
قالت ليريس فجأة:
– ما الذي يجعلك غاضباً هكذا؟ ما الذي يدفعك إلى كل هذا الإصرار الآن؟
حدقت فيها بدهشة وقلت: إنها مسألة مبدأ، لماذا يسمح لهم بالإفلات من هذا الغش والخداع؟ آن الأوان أن يتلقى هؤلاء الموظفون صدمة من شخص لا يمل من المتابعة.
أطلق ليريس تأوهاً خافتاً، خرج من فمها كصوت ضعيف، ثم أدارت وجهها عني، فيما كان بيتروس يفتح باب المطبخ ببطء ليغادر، مستشعراً أن الحديث تجاوز حده.
واصلتُ، كل مساء، طمأنة بيتروس، أردد عليه العبارات عينها، وبالنبرة ذاتها، غير أن صوتي كان يبهت شيئاً فشيئاً كل يوم. حتى بات واضحاً في النهاية أننا لن نستعيد جثمان شقيقه أبداً، لأن أحداً لم يكن يعرف مكانه حقاً. ربما دفن في مقبرة متشابهة القبور، كضاحية رمادية تمتد بلا ملامح، أو تحت رقم لا يخصه، أو لعلهم نقلوه إلى كلية الطب، حيث يُختزل الجسد هناك في طبقات من العضلات وخيوط من الأعصاب. ومن يدري؟ لم يكن له هوية في هذا العالم أصلاً.
حينها فقط، وبصوت يختلط فيه الخجل باليأس، طلب بيتروس أن أحاول استرداد المال. قلتُ إلى ليريس لاحقاً: يخال لك، من طريقة طلبه تلك، أنه يسرق أخوه الميت. ولكن كما ذكرت من قبل، كانت ليريس قد أصبحت شديدة التوتر إزاء هذه القصة، حتى إنها لم تعد تطيق ولو ابتسامة ساخرة عابرة مني.
حاولتُ استعادة المال. وحاولت هي أيضاً. كتبنا، واتصلنا، وجادلنا، لكن دون جدوى. بدا أن معظم النفقات كانت من نصيب متعهد الدفن، وقد أدّى عمله على أي حال. وهكذا غدا كل ما جرى إهدار كامل، بل كان ضياع أفدح لتلك الأرواح البائسة مما كنت أتصور.
أما العجوز القادم من روديسيا، فكان في حجم والد ليريس تقريباً، فناولته واحدة من بدلات والدها القديمة. وعاد إلى بيته في الشتاء وهو أوفر حظاً مما كان حين جاء.
….
ملاحظات المترجم
*يشير بيتروس إلى صاحب عمله الأبيض باسم baas؛ وهي كلمة “أفريكانية” يمكن أن تشير بمعناها الواسع إلى الزعيم أو الريس، أو السيد.. إلخ
** ترد في القصة بالشكل التالي paradise of zoot suits تعني عبارة zoot suits بالأساس زي رجالي كان رمزاً للأناقة؛ يتميز بسروال عالي الخصر وأرجل واسعة وفوقه جاكيت طويل نسبياً وصدريات واسعة وكتفين مبطنين عريضين، ظهر هذا النوع من اللباس في أربعينيات القرن الماضي وانتشر بشكل واسع، وكانت بدايته بين الأمريكيين من أصول أفريقية، والمعنى المجازي يشير إلى ثقافة معينة أو فترة زمنية محددة بصفتها رمزاً تمثل أسلوب حياة خاص أو تعبير عن الانتماء إلى ثقافة فرعية معينة، وتستخدمه الكاتبة هنا للدلالة على حالة ثراء ورفاهية والاستمتاع بالمزايا وملذات الحياة، وكما يبدو فهي استعارة مبالغ فيها لمكان ما يعتبر جنة أو مكاناً جذاباً بطريقة ما، وغي السياق سوف تكون مدينة جوهانسبرغ هي الفردوس الذي سيقصده سكان الدول المجاورة. كدلالة على الفارق بينها وبين غيرها من المدن بالنسبة للسكان السود آنذاك.
*** تعني كلمة “إيغولي Egoli بلغة الزولو “مدينة الذهب”، وهي ما يعرف الآن بمدينة جوهانسبرغ عاصمة مقاطعة غوتنغ Gauteng: وهي أكبر مدينة في جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا والمركز الصناعي الأول؛ ونمت مع إنشاء صناعة تعدين الذهب في العام 1886. وتدخل كلمة إيغولي في ثقافة جنوب أفريقيا بهذا المعنى تماماً أي مدينة الذهب لدرجة أنه أطلق الاسم على مسلسل شهير هناك بدأ عرضه في العام 1992 واستمر في البث حتى العام 2010
 Aljarmaq center Aljarmaq center
Aljarmaq center Aljarmaq center